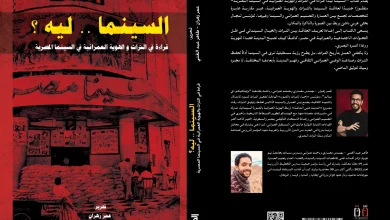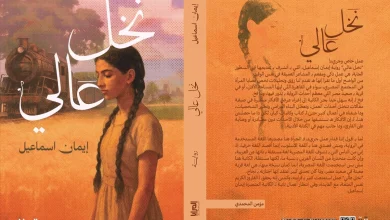ياسر منجي يكتب: تماثيل القاهرة (1-3)

«القاهرة الملكية 1952-1922: صفحات ومشاهد من عمران وثقافة المدينة» عنوان الكتاب الجديد الصادر عن دار العين، قام بتحريره د. نزار الصياد، وحسن حافظ، وشارك في كتابة فصوله: كريم بدر، ياسر منجي، عماد أبو غازي، كندة السمارة، عبد الرحمن الطويل، دعاء الأمير، عبد الحليم حفينة، هاله فودة، هشام عيسى، حامد محمد حامد، عاطف معتمد. يستعرض الكتاب بفصوله المختلفة التحولات في القاهرة التي ولدت من رحم إعلان الملكية والتي انتهت بحريق القاهرة في يناير 1952. وبإذن خاص من الدار اخترنا الفصل الخامس الذي يتناول فيه الدكتور ياسر منجي تاريخ تماثيل القاهرة، والصراع على الفضاء العام. ننشر على مدى عدة أيام.
كيف جرى خلقُ نَسَقٍ رمزي جديد لهوية مدينة القاهرة الحضرية، من خلال التماثيل الميدانية والنُّصُب التذكارية، على امتداد الفترة بين عامَي 1922 و1953؟ للإجابة، سيكون لِزامًا سَبرُ دور هذه التماثيل وتلك النُّصُب في تشكيل مظهر المدينة وتعزيز هويتها الثقافية والسياسية، في سياق التناقضات التاريخية التي اكتَنَفَت القاهرة خلال الفترة الاستعمارية البريطانية، وما تخلل هذا السياق من تحولات معقدة لتطور القاهرة الاجتماعي والسياسي؛ وبخاصة مع ما أسفرت عنه نتائج الحربين العالميتين، وتحولات الحركة الوطنية المصرية.
وبرغم أننا نهدِفُ في العموم إلى فهم سمات الفترة الزمنية المحددة سالفة الذِّكر، فسنَستهدي كذلك ببعض الأمثلة المهمة، التي نستدعيها من ذاكرة النحت في مصر خلال العهدين الخديوي والسُّلطاني؛ وذلك لتوضيح طبيعة التحولات التي جرَت من ثَمّ خلال العهد الملكي، وصولًا لتحولات ما بعد 23 يوليو 1952.
***
ما المفهوم الجوهري الذي تنتَظِم في سياقه أغلب الأفكار والفروض والتحليلات المزمَعِ عرضها، فهو الانطلاق من فكرة “السيطرة على المجال العام”، باعتبار هذه السيطرة رهانًا بين القوى الطامحة للهيمنة – سياسيًا، واقتصاديًّا، وثقافيًّا – على امتداد الفترة الزمنية التي نتناولها، وذلك من خلال سعي كل قوة من هذه القوى إلى تكريس رموزها ومتَخَيَّلاتها الجمعية، في صميم الوعي العام؛ بما يخدم مصالح كلٍّ منها، ويبَلوِر خطاباتها ومبادئها فنيًّا، بأقصى تأثيرٍ ممكن، ويجسّد للعيان الحمولات الفكرية المجردة التي تُضمِرُها هذه الخطابات.
ووفقًا لهذا المفهوم، كان التمثال الميداني والنصب التذكاري أداتَين من أهم أدوات تجسيد تلك الرموز، والمتَخَيّلات الجمعية، وهو ما تَجَلّى على أوضح ما يكون في قاهرة العهد الملَكي، لا بالمفهوم الحَرفي لتعريف المَلَكِيّة كنظام مرتَهِن بعهدَي “أحمد فؤاد الأول”، و”فاروق الأول” فحَسب، بل بالمفهوم الأرحب الذي لا يغفِل العلاقة التتابعِيّة العضوية والجَدَليّة بين الصِّبغات الخديوية، والسلطانية، والملكية، التي تلوّنت وفقًا لها عهود أفراد من أسرة “محمد علي”.
ففي رأينا أن الأواصر التي ربطت بين هؤلاء العواهِل، كانت أقوى من أن تفصِمَها الاختلافات بين صِيَغ الحُكم. فضلًا عن أن بعضهم كان نموذجًا لانسلاخ صيغةٍ من صيغة، وتحول نظامٍ إلى نظام؛ كما هو الحال في نموذج “أحمد فؤاد”، الذي بدأ سلطانًا، ليصير ملكًا.
***
فمما يجدر الانتباه إليه ظاهرة عدم حدوث انقطاعٍ باترٍ بين صِيَغ الحُكم التي مرت بمصر خلال تعاقب عهود حكام تلك الأسرة، كما كانت العديد من الشخصيات المؤثرة في إحداها لا تزال على قيد الحياة في لاحقتها، لعهدٍ أو أكثر، برغم تغير شكل الحكم. ويكفي الانتباه إلى حقيقة أن “مختار” (1891 – 1934) – صاحب التماثيل الأهم والأشهر في المنظومة النحتية التذكارية القاهرية – قد شهد ثلاثة أطوار من صِيَغ الحُكم المذكورة؛ بدءًا من دراسته بـ”مدرسة الفنون الجميلة” عام 1908 في الطَّور الخديوي خلال عهد “عباس حلمي الثاني”، مرورًا بنضجه الفني خلال الطور السلطاني في عهدَي “حسين كامل”، و”فؤاد”، وانتهاءً بتدشين أهم أعماله -“نهضة مصر”- خلال الطور الملكي بعد تنصيب “فؤاد” ملكًا. أي أن أشهر التماثيل الميدانية المصرية قاطبةً هو في حقيقة أمرِه نتاجٌ لما حَصَّله “مختار” من تعليم متخصص خلال العهد الخديوي، وإفرازٌ للظروف التي اكتنفَت العهد السلطاني، على رغم أن ثمرَتَه لم تُقطَف إلا خلال العهد المَلَكي.
مفهوم “إعادة التخصيص” Re appropriation
من هنا كانت ضرورة تحديد مفهوم “إعادة التخصيص”، الوارد ذكره في العنوان، والذي يمثل القاعدة التي سيجري وفقًا لها مقاربة النماذج النحتية والتذكارية الواردة في هذا الفصل، فهو مفهومٌ يقوم على علاقة جدليّة بين اعتبارَين دلاليَّين جوهريين، سيعتَمَدُ عليهما في بناء شبكة العلاقات السياقية الناظمة بين النماذج التي ستتم دراستها، وكذلك بين مختلف العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية المؤثرة على مجريات الأحداث ضِمن الإطار الزمني المركزي لهذا الفصل.
الاعتبار الدلالي الأول، الذي يرتكز عليه استعمال تعبير “إعادة التخصيص” في هذا الفصل، هو مفهوم إعادة تأويل رمزية المُنشأة – التمثال أو النُّصْب – أو رمزية الفضاء المكاني المرتبط بواقعة – أو وقائع – تاريخية مهمة، أو المرتبط بشخصية محورية، أو بنظام اجتماعي/ سياسي مركزي، بما يؤدي إلى الإفادة من أثر هذه الرمزية، أو بما يؤدي – في حال الصراع معها – إلى التخفيف من تأثيرها ما أمكن، أو إلى تحريف هذه الرمزية أحيانًا؛ لإنتاج معانٍ تختلف عمّا كان مأثورًا في الأصل عن الشخصية أو الواقعة المرتبطة بالتمثال أو النُّصْب والإيحاء به للوعي الجمعي. وقد ظهرت عدة نماذج تاريخية خلال العهد الملكي، يتجلى فيها هذا الاعتبار الدلالي الأول؛ في سياق التناحُر بين القوى السياسية المتصارعة على الإمساك بزمام الأمور آنئذٍ؛ كما سيأتي تفصيلُه لاحقًا.
***
أما الاعتبار الدلالي الثاني فهو ما يحمله التعبير من معنًى مباشر، يُحيل إلى فكرة فك الارتباط بين مُنشأة بعَينِها – تمثال أو نُصْب تذكاري – أو بين فضاءٍ مكانيٍّ محدد، وبين الدافع الأول الذي استوجب تشييد تلك المُنشأة، أو تنسيق ذلك الفضاء المكاني. ومِن ثَمّ إعادة السعي لإقامة روابط جديدة، رمزية و/ أو استحواذية، بين تلك المنشأة أو هذا الفضاء المكاني، وبين دافع جديد، معنوي أو مادي، بما يؤدي إلى تفكيك دلالاته الأصلية وإكسابه دلالات جديدة ترتبط حصرًا بالدافع الجديد الجاري تخصيصه له.
وقد ظهر هذا الاعتبار الدلالي على نحوٍ واضح خلال السنوات القلائل التي تَلَت سقوط العهد الملكي؛ إذ حدثت في بداية العهد الجمهوري – وعلى نحوٍ خاص خلال العقدين الأولَين منه – وقائع متعددة، بدا فيها جَلِيًّا تفعيل هذا الاعتبار، من خلال إجراءات، وقرارات، ومشروعات، ارتبطت إما بإعادة تخصيص منشآت تذكارية معينة وفقًا لرموز العهد الجمهوري، أو إزالتها تمامًا، وإعادة تخصيص فضائها المكاني لإحلال غيرها محلها، بما يعيد تشكيل الفضاء المكاني لصالح خطابات العهد الجمهوري ومبادئه ورموزه.
فعلى هذه الأُسُس، ووفقًا للمفاهيم سالفة الذِّكر، نُقاربُ الكيفيات التي تحدَّدَت وفقًا لها هويّة الفضاء الحَضَري المصري بأَسرِه، خلال تلك الحقبة، سواءٌ في تشكيل البِنيَة الصلبة لهذا الفضاء، نحتيًّا ومعماريًّا/ تذكاريًّا، أو في تشكيل تحولات الاتجاهات والمسارات، التي حددت كيفيات جريان التيارات الاجتماعية والثقافية، التي احتضنها هذا الفضاء، وأثرت فيه، وتأثرت به، والتي كانت من بين أحَدّ أسلحة السِّجال السياسي الدائر فيه، على امتداد النصف الأول من القرن العشرين.
نُذُر إعادة التخصيص الحداثي لفضاءات القاهرة الإسلامية
تقطع الوقائع التاريخية المُدَوّنة بوجود سوابق، كانت القاهرة الإسلامية خلالها عُرضة للتحولات التي طالت شكل الفضاء الحضري، على نحوٍ أدى لتنبيه الوعي الجمعي إلى أنماط من التكوينات التذكارية، التي تُكَرَّسُ في المجال العام للاحتفاء بذكرى عامة، وتخليد رمزٍ قوميٍّ مُجمَعٍ عليه.
ومن أهم الوقائع التي تعرّف خلالها المصريون القاهريون إلى فكرة (النُّصْب التذكاري) المتضَمّن بعض المنحوتات والتصاوير الجدارية، تلك الواقعة التي سجلها “الجبرتي” في كتابه “عجايب الآثار في التراجم والأخبار”- وكذا بألفاظٍ مختلفة في كتابه “مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس”- واصفًا احتفال جيش الحملة الفرنسية بذكرى العيد الوطني الفرنسي في منطقة “بِركة الأزبكية”، عن طريق إقامة نُصْب تذكاري من الخشب المغطى بأقمشة مزينة بتصاوير مُتقنة، ويحتوي على ما يشبه قوس النصر، وعلى تماثيل تتخلل آلات للألعاب النارية (1).
***
على هذا النحو، صار فضاء “الأزبكية” عُرضة لإعادة التخصيص الرمزي؛ بتكريس الرمز الفرنسي، فنيًّا وإنشائيًّا، في المكان نفسِه الذي استقر زمنًا طويلًا كرمز لنفوذ النُّخبة من بكوات مشاهير المماليك، ومُستَقَرًّا لإنشاء قصورهم المُترَفة، ومُتنَزّهًا لأهل القاهرة، في سياق نَسَق عُمراني يحكمه منطق الثقافة الإسلامية ويكتسب خصوصيّته من جماليات فنونها. وعلى هذا النحو أيضًا كانت مَفاعيل الحداثة الغربية تعبر عن تناقُضها مع بِنية القاهرة التراثية، وتمارس جَدَلَها الرمزي والفني – بدوافع سياسية لا يمكن إغفالها – مع فضائها الحضري. وكانت أولى أدوات ذلك التناقُض وهذا الجدل ممثلة في ذلك التركيب الاحتفالي الجامع بين النصب التذكاري والتماثيل، والتصاوير الجدارية على البوابات الرمزية.
ومِن اللافت للانتباه أن هذه الواقعة الأولى من نوعها أعقَبَت بعد ذلك أشباهًا لها، خلال مراحل تاريخية لاحقة، كانت الثقافة الغربية خلالها قد تخللت نسيج المجتمع المصري، القاهري على الأقل؛ وهو ما يؤكده ما نشرته جريدة “المقطم”؛ واصفةً احتفال الجالية الفرنسية في القاهرة بعيد الجمهورية نفسه، عام 1887، في عهد الخديو“توفيق”؛ إذ يقول الوصف:“… وأُقيمت عند مدخلها البحري قوس نصر رسم على واجهتها إلى جهة الباب صورة فتاة في مقتبل العمر وزهرة الشباب رمزًا إلى الجمهورية الفرنسوية…”(2).
وقد استمرت مظاهر احتفال الجالية الفرنسية بعيد 14 يوليو (اليوم الوطني الفرنسي Fêtenationalefrançaise/ يوم “الباستيل”) في نفس المكان بحديقة “الأزبكية”، وبنفس تكوينات أقواس النَصر، والنُّصُب التذكارية المؤقتة، متكرررة. وامتد تأثير هذه الاحتفالات لاحقًا ليشمل مظاهر احتفالية مصرية كبرى؛ مِنها ما كان معهودًا في أثناء الاحتفالات بعيد الجلوس الملكي المصري، خلال عهدَي “فؤاد”و”فاروق”، أو في الاحتفال بمناسبات رسمية وشعبية.
***
بل إن الظاهرة تطورت إلى درجة إقامة النُّصْب التذكارية الحجرية الدائمة، المتضَمِّنة تنويعات نحتية على درجة رفيعة من القيمة الفنية؛ ومِن ذلك النُّصْب التذكاري النحتي الذي أنشأته الجالية الفرنسية في “مقابر اللاتين” بالقاهرة -“مقابر طائفة الأقباط الكاثوليك” حاليًّا بمصر القديمة – عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ لتكريم ذكرى قتلاها في الحرب.
وظل هذا النُّصْب لسنوات عديدة خلال العهد الملكي مَقصِدًا للدبلوماسيين وكبار أعضاء الجالية الفرنسية، للاحتفال بعيد هُدنة الحادي عشر من فبراير، “هدنة كومبين الأولى” First Armisticeat Compiègne، التي انتهت بموجِبها الحرب العالمية الأولى. وقد تضَمّن هذا النُّصْب في قمته تمثالًا مُتقَنًا للديك الوطني الفرنسي (ديك الغال) LeCoq Gaulois، وكانت قاعدتُه تحاط بباقات الأزهار الضخمة خلال الاحتفال. (شكل 2. 5)

وعلى هذا النحو، لم يكن فضاء القاهرة الحضري خلال العهد المَلَكي خُلوًا من معالم التعبير عن وجود هذه الشرائح، من الأجانب والمستوطنين، الذين سعوا بدورهم لاقتحام الفضاء العام، وشَحنِه رمزيًّا بما يعكس أحداثًا كبرى، طال أثرُها مختلف أنحاء العالم، وتشابكت معها ظروف التحول الحداثي في مصر آنئذٍ.
مشاريع تكوين هوية بصرية للقاهرة في ظل دَيناميّة الاستقطاب
وبذلك ظهر ما يمكن تسميتُه بحالة بدء “الاستقطاب” بين (قاهرتَين): إسلامية راسخةٌ قِيَمُها في نفوس السواد الأعظم من أولاد البلد، وحداثية آخذة في التَفَّتُّح على هَدي قِيَم الحداثة الغربية، وعلى دوافع طُموح شرائح من النُّخَب السياسية والاجتماعية والفكرية، وهو طموحٌ كان قد تبلور على نحوٍ جَلِيٍّ في أعقاب توَلّي “محمد علي” مقاليد السُّلطة، ليرتفع مَدُّه في عهد “إسماعيل”.
إلى أن صار حقيقةً واقعة في أعقاب ثورة 1919، بتوَجُّهات جميع القوى الوطنية، التي وإن وقفت مواقف الخصومة من قوى الاستعمار الأجنبي، ومواقف المُناكَدة والمُشاكسة من حُكام الأسرة العَلَويّة، إلا أنها اتفقت – في شطرٍ كبيرٍ من تَوَجُّهاتها الثقافية – مع هؤلاء الفُرَقاء، في وجوب تَبَنّي مبادئ الحداثة، باعتبارها ضمانة لتحقيق مفهوم (النهضة). غير أن ذلك لا ينبغي أن يحجب حقيقة مهمة، ارتبطت تاريخيًّا بتحولات الفن الغربي، وتحديدًا في فرنسا، على أثر الحملة الفرنسية على مصر، وتتمثل في تَوَجُّه فرنسا لاستلهام الفن المصري القديم بصريًّا، فيما عُرِفَ بـ“طراز الصحوة المصرية” EgyptianRevival، المتميز باعتماده على الاقتباس من الفن المصري القديم واستلهامِه.
***
ولم يكن بالمُستَغرَبِ أن ينتقل هذا الأثر إلى مصر شيئًا فشيئًا، وأن يتبَيّن أثرُه بوضوحٍ في عهد “عباس حلمي الثاني”- من خلال تمثال “مصطفى كامل” المتأثر تصميمُه بهذا الطراز – ليرتفع مَدُّه إلى الذروة خلال عهد “فؤاد”؛ على أثر الالتفاف الشعبي حول تمثال “نهضة مصر”، الذي تبَنّى “مختار” لتنفيذه أسلوبًا لا يمكن إغفال أثر الطراز نفسه عليه؛ بتأثير بعثته إلى فرنسا وانخراطِه في أهم دوائرها الفنية والثقافية. وحتى بعد رحيل “مختار” عام 1934، ظل هذا الأثر المصري القديم –(الفرعوني) كما كان يتواترُ في أدبيّات تلك المرحلة – مهيمنًا على الفضاء الرمزي القاهري خلال عهد “فاروق”، عند إزاحة الستار عن تمثالَي “سعد زغلول”، في القاهرة، وكذا في الإسكندرية، عام 1938.
وقد اتَّسَمَت المحاولات الأولى لصياغة وتكريس هويّة بصرية مصرية محددة بطابعٍ مختَلَط Eclectic، وهو ما يمكن تتَبُّع جذورُه في إبّان عهد “محمد علي” (1769 – 1889)؛ الأمر الذي تطوّر على نحوٍ مُتَوالٍ خلال عهود عددٍ من خلفائه المباشرين، مُفصِحًا عن مَساعٍ مُبتَسَرة للدمج بين أكثر من صبغة ثقافية وقومية (3)، في سياقٍ محكومٍ بمُجمَل التحولات السياسية، الدولية والإقليمية، وما ترتب عليها من تحولات اجتماعية وثقافية وسياسية في الواقع المصري؛ مما أدى إلى السعي للتوفيق بين تلك الهويات، وتمازُجها بصورةٍ أو بأخرى؛ وهو ما ظهر أثرُه بأوضح ما يكون في تصاميم التماثيل الميدانية والنصب التذكارية كما سيأتي تفصيلُه.
***
من هنا صارت دَيناميّات ذلك “الاستقطاب” الجَدَلي المشار إليه مُراوِحةً بين ثلاث مرجعيات: إسلامية، ومصرية قديمة (فرعونية)، وحداثيّة أوربيّة، تنازعَت فيما بينها سَبق الهيمنة على رموز هوية مصر البصرية، مُعَبِّرةً في هذا التنازُع عن توَجُّهات القوى السياسية والثقافية الفاعلة في المشهد حينئذٍ، والتي سعت كل قوة منها إلى محاولة تغليب رموزها الخاصة، باستدعاء واحدةٍ من تلك المرجعيات الثلاث الرئيسة، أو للمزج بين أكثر من واحدةٍ، منها للتعبير عن خطابها، واقتحام الفضاء العام برموزٍ متجسّدة في الفراغ، وماثلة أمام جموع الشعب ليلًا ونهارًا؛ لا لترسيخ تلك الرموز والخطابات فحَسب، بل وللتدليل على قدرةٍ كلٍّ منها على حيازة نصيبٍ من هذا الفضاء العام نفسِه، على نحوٍ يلائم نسبة نفوذ كلٍّ منها، ويؤكد مدى تأثيره في مجريات الأحداث.
“قاهرة إسماعيل”: بين الاستقطاب وإعادة التخصيص
على الرغم من الأسبقية الزمنية لعهد الخديو “إسماعيل” (1830 – 1895) للحقبة التي يدور حولها المحور الرئيس للفصل، فإن استحضارها لا غنى عنه للكشف عن العديد من السمات والمبادئ، الجمالية والحَضَريّة التي أرساها هذا العهد، والتي ستظل حاضرةً بقوة طيلة العهد المَلَكي، لتُحدّد ملامح أساسية في هوية القاهرة البصرية.
كما أنه من نافلة القول أن تَبَنّي “إسماعيل” للمرجعية الأوربية، هو ما رسم معالم القاهرة (الجديدة)، التي صارت لاحقًا بؤرة الحراك السياسي خلال العهد الملكي، والبوتقة التي انصهرت فيها كل المعطيات والمتغيرات التي شكّلت صيرورة التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذت من القاهرة مركزًا لها على امتداد تلك الحقبة.
وقد كان التَوَجُّه للاستعانة بالنحاتين الأجانب، والفرنسيين منهم بخاصّة له ما يبرِّره، من عهد “إسماعيل” إلى عهد “عباس حلمي الثاني”(1874 – 1944)؛ لخُلُوّ الساحة آنئذٍ من النحاتين المصريين، إذ لم تكن “مدرسة الفنون الجميلة” المصرية قد تأسست بعدُ، وكان على المصريين الانتظار إلى عام 1908، ليبدأ أبناؤهم في الانتظام بصفوف دارسي الفن فيها، ثم الانتظار لسنواتٍ أخرى حتى يستوفوا تدريبهم وإحاطتهم بفنّيّات النحت الميداني، وأصول تصميم التماثيل الصرحيّة والنصب التذكارية.
***
ونتيجة لما سبق، كان لجوء “إسماعيل” إلى اثنين من أشهر النحاتين الفرنسيين في زَمَنِه، لنحت تماثيل الشخصيات الأربع التي أُنشِئت في عهده، بالإضافة لتماثيل أسود “قصر النيل” الشهيرة؛ التي تولى “هنري ألفريد جاكمار Henri Alfred Jacquemart، نحتها (1824 – 1896) إلى جانب تماثيل كلٍ من “محمد علي”، و”سليمان باشا الفرنساوي”، و”لاظوغلي”. بينما تولى “شارل كوردييه ” Charles Cordier (1827 – 1905) نحت تمثال “إبراهيم باشا”.
أنماط من إعادة التخصيص الرمزي في أعقاب ثورة 1919 وخلال العهد الملكي
وقد كان لتلك التماثيل تاريخٌ حافل من وقائع إعادة التخصيص، بمختلف أنماطها، استمرت مظاهرها إلى ما بعد عصر “إسماعيل”، بل وإلى ما بعد قيام الجمهورية. من ذلك ما نال تمثال “إبراهيم باشا” رمزيًّا؛ بتوظيفه دعائيًّا في أعقاب ثورة 1919، على نحوٍ يوحي بدلالات تعضد مكانة “سعد زغلول”؛ وهو ما رصده “أحمد شفيق” باشا في حوليّاته، وهو يصف مظاهر الفرح الاحتشادي العارم بعودة “سعد” ورفاقه من منفاهم عام 1921؛ قائلًا:
“ومما استلفت الأنظار منظر تمثال إبراهيم باشا القائم فى ميدان الأوبرا. حيث قبض بيده على علم مصري عظيم. وغُطي تمثال جواده بالأعلام الصغيرة كأنما هو يشترك مع الشعب في هذا العيد السعيد. وكان منظر التمثال يأخذ بمجامع القلوب”(4).
ومن اللافت في هذه الواقعة أن مَن عمَدوا إلى توظيف تمثال “إبراهيم باشا” في سياق الاحتفال بعودة “سعد” قد أعادوا تأويل إشارة يده الممدودة رمزيًّا؛ بحيث تؤدي بقبضه على العَلَم المصري الكبير للإيحاء برفرفة بشائر الاستقلال بمجرد عودة رمز ثورة 1919 من منفاه. وبذلك، غُيِّبَت – ولو لوهلة – الدلالة الأصلية لإشارة اليد المُوَجِّهة لقوات جيش “محمد علي”، لتحل محلها دلالة يدٍ تؤكد رمز الوطنية المُحتَفية بعهدٍ جديد، صارت فيه جموع المحتشدين السائرين أسفل التمثال مُعادِلةً لجنوده المنتصرين.
***
ويكفي لإدراك استمرار قوة الحضور الرمزي لتلك التماثيل (الإسماعيلية) في القاهرة الملكية، وإعادة توظيفها في إطار مناسبات جديرة بالتأمل؛ ما وثقته الصحف والمجلات المصرية في نهاية شهر أكتوبر من عام 1924. ففي تلك المناسبة، احتشدت الجماهير في “ميدان سليمان باشا” لتحية “سعد” وهو يستقل سيارة مكشوفة محاطة بفرسان يمتطون خيولًا بيضاء، بينما التَفّت أعداد من الشباب الوفدي في حلقات حول تمثال “سليمان باشا”، راكبين دراجات هوائية وهم يهتفون. (شكل3. 5).

ولم تخفَ دلالات هذه الوقائع الرمزية على الملك “فؤاد”، الذي سعى للإفادة من نتائجها الدعائية؛ من خلال التوظيف الرمزي للفضاءات الميدانية ذاتها، وللتماثيل الموجودة فيها، لتوطيد حضوره الموازي لحضور “سعد زغلول” الطاغي. وكمحاولة للتفوق على المواكب الوفدية، أضيفت لزينات استقبال الملك مُجَسّمات زخرفية، وبوابات تذكارية، وتكوينات كهربائية مصممة بإتقان، ومن أشهرها مجسمات التاج الملكي الضخمة المحلاة بالمصابيح الكهربائية، التي كانت تُرفَع لتزين “ميدان سليمان باشا”، فوق التمثال مباشرةً. (شكل 4. 5)

***
وعلى امتداد العهد الملكي، ظل حضور تماثيل “إبراهيم باشا”(5)، و”سليمان باشا الفرنساوي”، و”لاظوغلي”، حضورًا قويًّا؛ إذ تعددت مناسبات إعادة الاستدعاء الرمزي لهذه التماثيل من خلال الوسائط الصحفية، وبخاصةٍ على أغلفة أشهر المجلات المصورة آنئذٍ، وضِمن صفحاتها الداخلية المخصصة لرصد أهم الأحداث السياسية والعسكرية. وقد كانت أهم وسيلتين تُطَوَّعان وقتها لتحقيق هذا التأويل بصريًّا هما: تقنيات توليف الصورة الصحفية، “المونتاج”و”الديكوباج”، بالإضافة للكاريكاتير السياسي.
من ذلك مثلًا ما صَدّرَته مجلة “الاثنين والدنيا” على غلاف عددها رقم 273، الصادر في 4 سبتمبر 1939، بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع الحرب العالمية الثانية، واضطرار مصر للانخراط فيها بموجب معاهدة 1936، وما استتبَعَه ذلك من تأسيس “القوات المُرابطة” للدفاع عن المرافق الداخلية، وقطع العلاقات الدبلوماسية بألمانيا.
وقد لخصت هذه الأحداث رمزيًّا على غلاف المجلة؛ من خلال تكرار صور لصفوف من الجنود المصريين تمتلئ بهم خلفية المشهد تمامًا، ويطل عليهم تمثال “إبراهيم باشا” من فوق قاعدته، التي كتب عليها “المجد من ورائكم، والنصر أمامكم، فامضوا إلى الجهاد بعزم وإيمان”. وبذلك أعيد تأويل حركة يد التمثال الشهيرة؛ لتغدوا توجيهًا يتلقاه جنود مصر على مشارف الحرب العالمية الثانية، مثلما سبق وتلقاه أسلافهم؛ في مقابلة مجازية تربط الماضي العسكري لجيش “محمد علي” بقيادة “إبراهيم” بحاضر الأحداث المشتعلة عالميًا على مشارف الحرب العالمية الثانية. (شكل 5. 5)

***
من المفارقات أن يصدُر هذا العدد في صبيحة نفس اليوم – 4 سبتمبر – الذي تدخل فيه الملك “فاروق” لمنع إعلان الحرب، وتوجيه رئيس وزرائه “علي ماهر”، بالعدول عن القرارات التي اتخذتها وزارته لإشراك مصر في الحرب ضِمن صفوف الحُلفاء؛ وهو ما نتج عنه تقدُّم “ماهر” يوم 9 سبتمبر – بعد خمسة أيام من صدور العدد – بخطابه الشهير للاعتذار لبريطانيا عن عدم إعلان مصر الحرب.
وحين آذَنَ عهد “فاروق” بالأفول، جرت محاولة لإعادة تخصيص تمثال “إبراهيم باشا” رمزيًّا، بما يفضي إلى الإيحاء مِن طرفٍ خفيّ بانحدار “فاروق” من أرومة ذات عراقة عسكرية، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من اشتباك الجيش المصري في معارك حرب فلسطين عام 1948، فضلًا عن أن تلك المرحلة نفسها كانت قد بدأت تشهد اهتزازًا لصورة “فاروق” في عيون المصريين، بعد أن خابت فيه آمالهم العِراض التي استَهَلّوا بها عهده بحماسٍ مفرِط.
***
ففي سبتمبر من عام 1948، أمر “فاروق” بإعادة تركيب اللوحتين البرونزيتين، اللتين سبق وأن اعترضت تركيا على تثبيتهما على قاعدة تمثال “إبراهيم باشا” عند إنشائه في عهد “إسماعيل”؛ بسبب تصويرهما لانتصار المصريين على الأتراك في معركتَي “نزيب” و”عكا”.
ونظرًا لضياع اللوحتين الأصليتين اللتين نفذهما “كوردييه”، فقد لجأ القصر الملكي إلى وزارة المعارف، التي أسندت إلى النحاتَين المصريَّين “أحمد عثمان” (1907 – 1970) و”منصور فرج” (1909 – 2000) إعادة تنفيذ اللوحتين اعتمادً اعلى صور فوتوغرافية للأصول المفقودة. وكان الغرض المُعلَن من ذلك هو مناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على وفاة “إبراهيم”(6)، والذي كان يوافق 10 نوفمبر 1948.
وبرغم أن أسباب اعتراض تركيا كانت قد زالت بزوال دولة الخلافة العثمانية، وبقيام تركيا الكمالية، فقد اعترضت تركيا على تركيب اللوحتين على قاعدة التمثال للمرة الثانية! (7). وبحلول عام 1950، تم تركيب اللوحتين أخيرًا، ولكن دون أن تؤديا الغرض الاحتفالي المُعلَن لهما؛ بمرور عامَين على احتفال مئوية “إبراهيم”، وبعد أن انقضى أكثر من عام على اتفاق توقيع الهدنة بين مصر وإسرائيل في فبراير من عام 1949.
صراع تمثال “مصطفى كامل” من الخديوية إلى المَلَكية
على رغم أن تمثال “مصطفى كامل” نفذ خلال عهد الخديو “عباس حلمي الثاني”، فقد شهدت علاقته بالفضاء الحضري المصري أطوارًا ثلاثة، تعاقبت خلال ثلاثة نظم للحُكم، وعبرت عن تناقُضات الجَدَل السياسي الدائر خلالها. ففي الطَور الأول، بدأ تمثال “مصطفى كامل”(خديويًّا)، منذ وصوله إلى القاهرة في يناير من عام 1914، بعد تنفيذه في فرنسا بواسطة النحات “ليوبولد سافين” Leopolde Savine، الذي أتَمَّه عام 1910 (8).
ورغم عرضه في معرض باريس للفنون الجميلة في مايو 1910، فإنه ظل ثاويًّا داخل الصناديق التي أرسِل فيها لمدة أحد عشر عامًا (9)، دون أن يتاح له شَغل فضاءٍ مكانيّ يتناسب مع مكانة صاحبه ولا مع قيمته الفنية؛ لأسباب تتعلق بموقف قوى الاستعمار الإنجليزي من مشروع “مصطفى كامل” الوطني، وكذا لأسباب متعلقة بالسياسات الحزبية المتقلبة وقتها. ونتيجة لفشل المحاولات المتعددة آنئذٍ لإقامته في مكانٍ مناسب، فقد انتهى به طوره الثاني إلى أن يقامَ في “مدرسة مصطفى كامل” في حي “الخرنفش”، وهو ما تم عام 1921 في عهد السلطان “أحمد فؤاد”.
***
وفي الطَّور الثالث، أسفِر عنه (مَلَكِيًّا)، حين أزاح الملك “فاروق” الستار عنه في 14 مايو من عام 1940 في إبّان وزارة “علي ماهر”، في موقعه الجديد بميدان “سوارس” الذي أطلق عليه لاحقًا اسم “ميدان مصطفى كامل”. وكان هذا الإشهار المتأخر للتمثال ثمرة لجهود مجموعة من رجال الحزب الوطني وأنصاره، على أثر رفع الستار عن تمثالَي “سعد” في القاهرة والإسكندرية (10) يوم 27 أغسطس 1938؛ وهو ما يعكس بوضوح كوامِن النزاع بين حِزبَي “الوفد” و”الوطني” وقتها (11).
وقد عدل اختيار مكان إقامة تمثال “مصطفى كامل”، من “ميدان الملكة فريدة”(العتبة الخضراء)، إلى “ميدان سوارس”. وكان هذا التعديل ضربًا من “إعادة التخصيص” المكاني، الناتج عن مواءَمات سياسية، وسجال رمزي مضمر، بين “الحزب الوطني” و”الوفد”، تم تبريره بمبررات فنية وإنشائية صدرت للتداول العام؛ حين كان الخيار مطروحًا في بدء إقامة تمثال “سعد” القاهري، للمفاضلة بين ميدان “الملكة فريدة” و”ميدان الجزيرة”، الذي اختير لتمثال “سعد”، ليخلو مِن ثَمّ ميدان “الملكة فريدة” لتمثال “مصطفى كامل”(12).
***
ولكن وزارة الأشغال تبينت أن سعة الميدان لا تناسب حجم تمثال “مصطفى كامل”… وبعد القيام بالتجارب الفنية اختير ميدان سوارس وسمي ميدان مصطفى كامل. وحرص القائمون على أمر الإنشاء أن يوثقوا واقعة الاكتتاب الشعبي لإقامة التمثال على أحد جوانب قاعدته (13). وهو ما يفصِح عن حرص “الحزب الوطني” على معادلة الهالة التي سبق وأن أحاطت بتمثال “نهضة مصر”؛ حين اكتتبت الأمة لدعم مشروعه. ويتأكد هذا السجال الرمزي بين حزبَي “الوفد” و”الوطني” مما ورد حول مقاطعة رجال “الوفد” لحفل رفع الستار عن تمثال “مصطفى كامل” (14).
أما المستوى الثاني من السجال السياسي – وهو الأعمق – والذي ارتبط بحفل رفع الستار عن تمثال “مصطفى كامل”، فكان متصلًا على نحوٍ مباشر بما سبق ذكرُه، من تدخل الملك “فاروق”- قبل ثمانية أشهُر – لوقف إعلان مصر الحرب في صفوف الحلفاء عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتوجيهه رئيس الوزراء “علي ماهر” بإعداد بيان الاعتذار الخاص بذلك. ومن جانبٍ آخر، كان توتر العلاقة بين “فاروق” و”مصطفى النحاس” زعيم الوفد، وعَرّاب معاهدة 1936، وبخاصة بعد إقالته في نهاية ديسمبر 1937، سببًا إضافيًّا لمقاطعة الوفديين للحفل.
وكانت حكومة “علي ماهر” وقتها تواجه موقفًا صعبًا للغاية (15). وقد تجلّى ذلك في حفل رفع الستار عن التمثال من أكثر من زاوية؛ أهمها الخطاب الحماسي الذي ألقاه “علي ماهر” في الحفل، والذي فاض ثناءً على “مصطفى كامل”- الخصم اللدود لإنجلترا – وإشادة بوطنيته، وربطًا بين مساعيه لاستقلال مصر بما تم جزئيًّا في عهد “فؤاد”، وما هو مأمول في عهد “فاروق” (16).
هوامش
- الجبرتي، ص52.
- جريدة المقطم، العدد 718، 15 /7 / 1891، ص3.
- ياسر منجي، 2023.
- أحمد شفيق، 2012، ص303.
- “المصور”، 5 ديسمبر 1924.
- آخر ساعة، 8 سبتمبر 1948.
- آخر ساعة، 9 أغسطس 1950.
- عبد الرحمن الرافعي، 1957، ص78.
- المصور، 1 مارس 1940.
- المصور، 9 سبتمبر 1938.
- إبراهيم عبد الله المسلمي، 1989، ص205، 206.
- المرجع السابق.
- مقال “لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة”، 1940.
- عبد الرحمن الرافعي، 1947، ص79.
- صبري أبو المجد، 1987، ص152.
- عبد الرحمن الرافعي، 1947، ص79، 80، 82