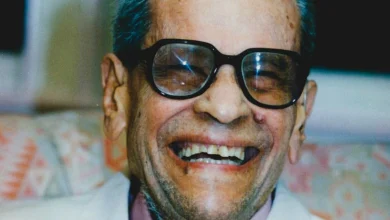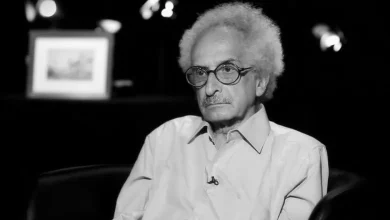ليدا منصور تكتب: نجيب محفوظ .. وجسور لبنان المهدَّمة

خلال عطلة الصيف، وأنا في مكان بعيد، كنت أعمل على التقرب مما آلفه، فحجزتُ سفري من باريس إلى بيروت للالتقاء بعائلتي وأحبابي. لكن تم إلغاء سفري خلال شهر تموز/يوليو ٢٠٠٦ بعد أن أغلق مطار بيروت.
فباسم مبدأ “عزل مسرح العمليات”، قررت قيادة الجيش الإسرائيلي فرض حصار على الموانئ والمطارات ومهاجمة خزانات الوقود، وذلك بهدف منع نقل جنود إسرائيليين أسرى إلى شمال لبنان أو إيران. تعرض لبنان منذ اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي لأربعين غارة جوية. استُهدفت الجسور والطرق والمطارات والموانئ والمصانع ومحطات الكهرباء ومستودعات الوقود، ودُمِّرت مئات المنشآت والبنى التحتية. ولن أضيف عدد الضحايا ولا أعمارهم، فالبحث عبر غوغل يفي بالغرض.
ومع تدمير الجسور، انتشرت ردة فعل نفسية لدى اللبنانيين تمثلت في تكرار أغنيات لفيروز تحتوي على كلمة “جسر“، ارتباطًا بالشعور المرعب بالتخريب. وكان الجسر – الذي يربط إنسانًا بإنسان، ومكانًا بمكان، وحاضرًا بمستقبل – هو ما تستوي عنده كل الحروب: صلة وصل انقطعت، يد مساعدة انحسرت، مشاعر تقلصت، ودموع حزن جفّت فاختفت.
لماذا نجيب محفوظ؟
في نهاية حرب تموز، سمعتُ خبر وفاة نجيب محفوظ في 30 أغسطس/آب 2006. كنت حينها قد بدأتُ قراءتي لأعماله، حيث اخترتُ “الثلاثية” كمسرح أعزل فيه معظم الأعمال النقدية المُبسِّطة والمُقارِنة والمُسهِلة لفهم النص المحفوظي، دون أن تُؤدّي هذه الأعمال فعلاً إلى تحليل النص وفهمه بحق. كأنني بدأتُ حربي الخاصة لكي أنقذ الثلاثية مما قرأتُه من أقاويل وإشاعات وإسقاطات سياسية واجتماعية واشتراكية وفلسفية ودينية وثورية وتقليدية ونسوية (وليس قضية تحرير المرأة). فتبنّيتُ دراسة “الإنسان إذا نطق” أي الحوار الداخلي للشخصيات، كفسحة حرية للتعبير غير مُقيَّدة بسلاسل العيب والمفروض والممنوع والحياء، وبعيداً كل البعد عن وصفات المطبخ التي تُرشُّ عليه “بهارات الواقعية”.
سألتُ نفسي حينها: ما هو الجسر الذي يربطني بنجيب محفوظ؟ هل كان الرابط هو تحرير محفوظ من سطحية النقد؟ أم فهم أسباب نيله جائزة نوبل؟ أم نزوة تتعلق بحب والدتي لمصر (سينما وتاريخًا)؟ أم مجرد صدفة؟
نحن لا نجد الإجابة في معظم الأحيان. وعندما تتضح الفكرة، نجدها في وقت متأخر حيث تفقد العلاقة الكثير من رونقها وعذوبتها. خلال خمس سنوات من تحضير رسالة الدكتوراه، قرأتُ محفوظ كلمة كلمة، وأعدتُ قراءة النص عدة مرات. ثم قرأتُ أجزاء من الثلاثية باستمرار ثم أعدتُ قراءة تحليلي وفهمي له بعدد لا يُحصى. لم أنم الكثير من الليالي وتوقفتُ عن السفر، ككل باحث مبتدئ يتوق إلى الكمال. لم أتعب يوماً من عملية تكرار قراءة النص نفسه، فكان شعور “عدم التعب” بحد ذاته جسراً يصلني بنجيب محفوظ وإن كان غائباً.
ألا تتعب من حب طفلك؟ قد تكون هذه تركيبة تلقائية وعفوية، لكن علاقتي بمحفوظ لم تكن يوماً حباً وأمومة، فما سر انعدام الكلل؟ السر يكمن في عناصر كانت تجذبني في أعماله.
نساء نجيب محفوظ
منذ سنتين، شجعني أستاذ الأدب العربي حسين حمودة على كتابة بحث صغير عن النساء في أعمال محفوظ. كنتُ في مرحلة الصمت تجاه الرسالة المنتهية وتجاه محفوظ الصامت أيضاً في أعماقي. لم أستطع حينها كتابة أي شيء، لم يكن تعباً بل خجلاً، نعم، خجلتُ أن أُعبِّر عن إعجابي وتقديري لامرأة واحدة فقط!
لم تكن هذه المرأة “عايدة”، نموذج المرأة المودرن المصرية البرجوازية التي تعيش في قصور القاهرة الجميلة، المرأة التي تتكلم الفرنسية وتلعب الرياضة وتسافر إلى الأهرامات مع أخيها وأصدقائه، المرأة التي أحبها كمال بمثالية. عايدة، وبعد زواجها من رجل من وسطها وسفرها إلى أوروبا، خُذِلت وعادت إلى مصر شخصية عادية لم يعد لها صوت مميز في ثلاثية نجيب محفوظ.
ولم تُعجبني “عائشة”، من عائلة برجوازية وسطى تعيش في الأحياء القديمة. عائشة الجميلة التي كان الجميع ينظر إليها بإعجاب، عائشة التي أحبت رجلاً لم تتزوجه بل رضيت بخيار أبيها. عائشة التي فقدت ابنها بسبب المرض فعاشت آخر أيامها، وبعد عودتها إلى بيت أهلها، وحيدة تائهة، تسمع ما يقوله الآخرون دون أن تستجيب وكأنها غائبة عن الوعي تتكلم عبر جوارحها الداخلية فقط.
** **
أما المرأة الوحيدة التي أعجبتُ بها خفياً فهي زوجة ياسين الثانية “زنوبيا”: عازفة عود تنتمي إلى عالم الراقصات. المرأة التي وبكل هدوء ودون جهد دخلت إلى عالم العائلة البرجوازية. قررت زنوبيا أن تترك حياة الليل فطمحت بالارتقاء عبر الوسيلة الوحيدة المتوفرة لها في زمنها ومجتمعها، أي الزواج. فمن “عالِمَة” وعوَّادة إلى عشيقة للأب أحمد عبد الجواد ثم عشيقة للابن الأكبر ثم أصبحت الزوجة الرسمية والشرعية الثانية لياسين رغم الضغوطات التي حاول الأب أن يمارسها على ابنه.
مع العلم أننا نغوص في عالم تقليدي، فإن قصة زنوبيا أشبه ما تكون برواية “سندريلا” تصعد في السلم الاجتماعي. إنها قصة حب وزواج حديثة للغاية، على الرغم من البيئة التقليدية. زنوبيا ليست فقط امرأة حرة وقوية بشكل سري، بل إنها ترتقي في السرد القصصي للراوي عبر جعلها أُماً تلد طفلها في نفس اليوم الذي أُعلن فيه عن وفاة زعيم سياسي كبير في ذلك الوقت، سعد زغلول. وهكذا، تصل إلى مكانة “مانحة الحياة” في أوقات عصيبة للشعب المصري.
لا شيء أفضل من شخصية زنوبيا للتعبير بصوت عالٍ عن قضية تحرير المرأة. كان موقف نجيب محفوظ من قضية المرأة، حسب رأيي، هو أنه خالف كل التوقعات. وما أجمل من امرأة اكتسبت دور وشخص وقرار “أن تخالف كل التوقعات” فتصبح “سندريلا الخادمة” أميرة تسكن القصور. هل يكفي هذا الإعجاب والتقدير لزنوبيا أن يبرر مشاعر عدم التعب في كل موقف أتحدث فيه عن محفوظ، إن كان عبر الإذاعة أو بعض المقالات أم أمام إنسان مستمع يسألني: لماذا محفوظ؟ الإعجاب كما الحب ليس له أسباب واضحة لكننا نستطيع على الأقل إيجاد بعض الدوافع.
الحرام والحلال
عندما تعمقت في قراءة سيرة محفوظ، اكتشفت أن مقص الرقابة قد وصل للكثير من أعمال محفوظ. لم أكن أدرِ أن روايات محفوظ خضعت بشكل دائم لقسوة الرقابة، بالإضافة لقسوة النقد اللاذع من القريب والبعيد، كيوسف إدريس مثلاً. ما هو الحلال وما هو الحرام؟ فتلك مواضيع معروفة لدى القارئ والكاتب والإنسان العربي، أما عن الفكرة الوحيدة التي علقت في وجداني وذهني فهي ردة فعل محفوظ. الإنسان الأنيق والهادئ والعنيد والصبور والثابت رغم كل شيء.
من أين له هذا الصبر؟ ومن أين له تلك العزيمة؟ كيف استطاع تقبُّل الرقابة ومتابعة الكتابة والإصرار على النشر و**”اللا-أخذ-بعين-الاعتبار”** للانتقادات والقراءات السطحية لأعماله؟
فتذكرتُ أنني عندما أرسلت رواية أولى لي لدور نشر، كان الرفض الذي تلقيته كجسر دمرته إسرائيل، فقد توقفتُ عن الكتابة بل وعن المحاولة لمدة سنوات. أما نجيب محفوظ، وبالرغم من السكين في عنقه بعد محاولة اغتياله، تابع وأكمل… تابع وأكمل الكتابة، وبعد فترة النقاهة بدأ يتكلم ويلقن الكلمات بعد شلله. فتذكرته مجدداً عندما أصبتُ بالخوف الأكبر أمام الدكتور عندما أخبرني هذه السنة عن عوارض الروماتيزم في أصابع يدي اليمنى فسألتُ نفسي: “أتوقف عن الكتابة أم لا أتوقف؟”
حتى آخر يوم من عمره، كتب نجيب محفوظ بلا كلل ولا تعب.
الامتنان للأجداد
يصبح حينها نجيب محفوظ نموذجاً ومثالاً أقتديه، وأشعر بالامتنان له ولكل إنسان لم تثبط عزيمته ولم تهزها الرياح… من الممكن أن نتوقع أو نتخيل أنه عانى من الرقابة بصمت وقهر، لكنه فعل ما لا يستطيع فعله الكثيرون، أي المتابعة، ولم يقطع جسر الإبداع والإنتاج والنشر. فكان السؤال: هل الصبر والتواضع والثبات يشكّلان أساساً من أسس الحرية للإنسان؟
من هنا، بدأتُ أُدرك ما معنى “عدم التعب والكلل والضجر” في متابعة أعمال محفوظ وأخباره. وكما قالت الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس في إحدى رواياتها: “الحب ليس علاقة بل الحب “مهنة””، فمتابعة وقراءة ودراسة واستحضار نجيب محفوظ مهنة بحد ذاتها.
وبهذا الشكر والامتنان أتذكره. وفي الختام، أدعو كل إنسان عربي أن يتذكر محفوظ ويشكره هذا اليوم عبر تذكر ما سمعه عنه وما قرأه له وحتى عبر ما لم يقرأه بتاتاً!
علينا أن نعتبر محفوظ “الجدَّ الكبير” الذي وضع أحجار أساس للأحفاد ليكتسبوا قوة الانتماء والارتقاء لكتابات وروايات وإبداعات وأفكار وأفعال وقرارات حياتية حرة وحديثة وعنيدة. أخيراً، إن قول الأجداد صادق: “اللي ماله قديم، ماله جديد”.
د. ليدا منصور، باحثة وكاتبة من فرنسا