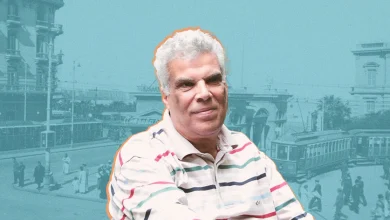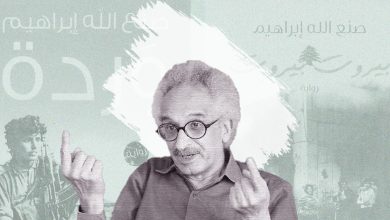قاهرة يوليو (16): «عمارة يعقوبيان» وتحولات الزمان والمكان (1-2)

التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها مجتمع القاهرة، وكذلك التحولات في المشهد العمراني، كان موضوع عدة روايات صدرت بعد العهد الناصري مثل “قالت ضحى” (1985) و”قطعة من أوروبا” (2005). أفاد جيل من الروائيين من المناخ السياسي الجديد في فترة ما بعد ناصر، لاسيما بعد أن تحولت إيديولوجية الدولة التي كانت موجهة نحو الاشتراكية والقومية العربية على يد أنور السادات (1970-1981) وحسني مبارك (1981-2011).
***
من بين الروايات الأكثر شهرة ومبيعًا خلال بدايات الألفية، رواية عمارة يعقوبيان (2002) لعلاء الأسواني. وبرغم أن الرواية تستحضر وسط المدينة خلال فترة التسعينيات، فإن الفصول الأولى تناولت تحولات وسط المدينة في العهد الناصري، من خلال قصة عمارة قديمة بُنيت عام 1934. وبما أن فترة وقوع الأحداث ليست الموضوع الرئيسي لحلقات “قاهرة يوليو”، فإننا سوف نكتفي بالتوقف عند الفصول الأولى من الرواية، مع ديالوج في ختام الرواية حول رحيل الأجانب وموقف المصريين من جمال عبد الناصر.
في جميع كتاباته، يستحضر الأسواني القضايا الاجتماعية والسياسية الكبرى على المستويين الوطني والعالمي مثل التطرف والفساد والفقر. وتولي روايات الأسواني أهمية كبرى لأنماط المجتمع المصري. من خلال شخصيات رواياته، يصور الأسواني الحياة اليومية للمصريين، تقاليدهم ومزاجهم، وأفراحهم وآلامهم، هكذا يصف: “ما دمت أكتب روايات عن المجتمع المصري، فيجب أن أعيش في وسطه”.
***
وعن مصدر إلهام عمارة يعقوبيان، كتب الأسواني: “كنت أسير في أحد شوارع جاردن سيتي عندما رأيت عمارة قديمة بجوار السفارة الأمريكية يتم هدمها. تأملت الجدران المنهارة. كانت تخفي وراءها متعلقات الناس الذين سكنوا هذه العمارة لسنوات، وكانت تضم ذكرياتهم وحكاياتهم. وبينما كنت منهمكاً في التفكير فيما شاهدته، قررت أن أبدأ في كتابة رواية محورها العمارة التي يمكن أن تشارك في الأحداث من خلال التعبير عن التغيرات التي يمكن أن تحدث لمجموعة من الناس”.
استلهم الأسواني إذن كتابة الرواية إذن من عملية هدم المباني القديمة، وهي التي بدأت منذ 1952 وتواصلت فيما بعد. والرواية قائمة أساسًا على تيمة التحول المكاني والسياسي الاجتماعي الذي تتعرض له عمارة سكنية تجمع سكاناً من أجيال مختلفة ومن خلفيات اجتماعية متنوعة.
يتوافق ذلك مع رأي الناقد الأدبي مارك كوبر في الرواية، والذي يؤكد فيه أن عمارة يعقوبيان تبرز أهمية التحولات العمرانية في مصر الحديثة. هذه التحولات، بحسب كوبر، “مرادفة لمراهنات ثقيلة على استمرارية الأنظمة السياسية التي لا تنجح في حل مسألة تدهور أجزاء كاملة من النسيج العمراني […]”. تجدر الإشارة إلى أن نجاح الرواية قد جذب الانتباه على المستويين الوطني والدولي إلى القيمة المعمارية والعمرانية لوسط مدينة القاهرة، حيث أصبح الحفاظ على تراث المنطقة قضية وطنية منذ التسعينيات.
***
عمارة يعقوبيان هي مبنى قائم بالفعل، وتقع في شارع طلعت حرب في قلب وسط المدينة. إلا أن الرواية تلقي من خلالها نظرة ثاقبة على سكانها كأنها عالم مصغر للمجتمع المصري مجتمعًا في مكان واحد متناولةً العديد من القضايا مثل إساءة استخدام السلطة والفقر والفساد الاجتماعي المستوطن وتجارة المخدرات والإرهاب. كل هذه القضايا تتقاطع مع حياة سكان العمارة التي تجمع هذه الطبقات المتناقضة والمتصارعة دائماً.
أما العمارة، فتتعرض أيضاً لتحولات سياسية واجتماعية ابتداءً من 1952 وتصبح المثال النموذجي لعمارات وسط المدينة. تحولات في الاستخدام نتيجة لعمليات فرض الحراسة والمصادرة، وفقاً لمبدأ الخلافة السكنية (تناولناه في الحلقة 11)، التي لم تنج من الفساد، تؤدي إلى تدهور العمارة. الانفجار العمراني في القاهرة يؤثر على العمارة التي تتحول إلى “جزيرة مكتظة بالسكان” تحت الضغط الديموغرافي. بشكل أعم، العمارة تحكي قصة مصير وسط المدينة. كما يوضح كوبر، الرواية “رمزية لمصير الحي العصري والأوروبي المؤسف في القاهرة”.
عمارة يعقوبيان تبدو وكأنها مكان مسرحية تتكشف عليها أحداث ناتجة عن التحولات السياسية والاجتماعية التي يتعرض لها البلد ابتداءً من 1952. الوصف والمواقف التي يحكيها الراوي تمثل كل ساكن من سكان العمارة كوحدة اجتماعية فريدة أو كيان مستقل.
***
نذكر على سبيل المثال زكي بك دسوقي، أحد أقدم سكان العمارة منذ نهاية الأربعينيات، هو يمثل تاريخ الحي قبل 1952 وهو نجل وزير سابق كان “باشا” وفدي، درسزكي الهندسة في فرنسا وحصل عند عودته على لقب بك. لكن أحلامه بمستقبل واعد تبخرت بعد ثورة 1952: حوكم والده أمام محكمة الثورة وصودرت ممتلكاته، فمات متحسرًا عليها. أما الابن، زكي، فيصفه الراوي كشخصية “أسطورية”حتى أن سماته الشخصية تعطي فكرة واضحة عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها:
“وهو يشكل بالنسبة لسكان الشارع شخصية فلكلورية محبوبة عندما يظهر عليهم ببدلته الكاملة صيف شتاء التي تخفي باتساعها جسده الضئيل الضامر ومتديله المكوي المتدلي دائماً من جيب السترة بنفس لون رابطة العنق وذلك السيجار الشهير الذي كان أيام العز كوبيا فاخراً فصار الآن من النوع المحلى الرديء المكتوم ذي الرائحة الفظيعة، وجهه المتغضن للعجوز ونظارته الطبية السميكة وأسنانه الصناعية اللامعة وشعره الأسود المصبوغ بخصلاته القليلة المصففة من اليسار إلى أقصى يمين الرأس بهدف تغطية الفسحة الملعونة الجرداء.
باختصار يبدو زكي الدسوقي أسطوريا على نحو ما، مما يجعل حضوره مشوقا وغير حقيقي تماما (كأنه قد يختفي في أي لحظة أو كأنه ممثل يؤدي دورا) ومن المفهوم أنه بعدها يفرغ سوف ينزع عنه ملابس التمثيل ويرتدي ثيابه الأصلية”.
***
كان يكفي ذكر نوع السيجار الذي يدخنه زكي الدسوقي لوصف تحول نمط الاستهلاك للطبقة الأرستقراطية من قبل 1952 إلى ما بعدها. مظهر البك السابق الأنيق يؤكد انتماءه لعهد مضى ويصبح لاحقاً في نظر الراوي وبالتبعية للسكان، شذوذا أقرب للفلكلور. علاوة على ذلك، زكي بك يمثل المعارضة الكاملة للنظام الحاكم الذي يعتبره نظاماً سلطويًا أجهض الحياة الديمقراطية ودفع بالبلاد إلى هوة الانحطاط. في رأيه، الحياة الديمقراطية في مصر كانت فقط في عهد الملكية التي أطاح بها ناصر وصحبه. منذ ذلك الحين، سقطت مصر “في الفقر والفساد والفشل في جميع المجالات”.
من بين شخصيات الرواية الحاج عزام. وهو مليونير ستيني، يمثل طبقة رجال الأعمال الذين ازدهروا في فترة الانفتاح الاقتصادي. أصله كان مهاجرًا من الذين بدأوا مسيرتهم المهنية في وسط المدينة منذ الستينيات: جاء من محافظة سوهاج لتلميع أحذية المارة في شارع سليمان باشا ثم اختفى ليعود بعد عشرين عاماً، فاحش الثراء مفسرًا ذلك بأنه كان يعمل في بلد خليجي لكنه في الحقيقة وفيما بعد، يكتشف القارئ مصدر ثروته: تجارة المخدرات.
***
في الرواية، يملك الحاج عزام محالاً في الطابق الأرضي من عمارة يعقوبيان. عزام يمثل الطبقة الطفيلية من الأغنياء الجدد أو “القطط السمان”. يُوصف عزام بأنه شخص له “ميل لا يقاوم لشراء العقارات والمحال في وسط المدينة” لدرجة أنه يصبح “بلا منازع زعيم شارع سليمان باشا. يلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم ومساعدتهم”. أخيرا، ينجح عزام في الانضمام إلى الحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي) وينتخب، بعد انتخابات مزورة، عضواً في البرلمان عن دائرة قصر النيل.
في الرواية يمثل جيل الشاب طه وحبيبته بثينة. هما جزء من مجتمع سطح عمارة يعقوبيان. بثينة هي الابنة الكبرى لأسرة فقيرة تضطر لترك دراستها والعمل بعد وفاة والدها لإعالة أسرتها. تعمل كبائعة في متجر في وسط المدينة فيستغلها صاحبه جنسياً.
بينما طه، ابن البواب والطالب المتفوق، يطمح لدخول كلية الشرطة. لسوء الحظ، تم رفضه بسبب مهنة والده، وهي واقعة تسلط الضوء على عدم المساواة الاجتماعية والفساد المؤسسي. تتحول حياة طه بعد ذلك: يترك بثينة التي تربطها علاقة بزكي دسوقي بعد أن أصبحت سكرتيرته. وينخرط في سلك الجماعات الأصولية، لاحقاً يُعتقل ويُعذب من قبل أمن الدولة. للانتقام، يتبنى طه فكرة عنف الجماعات الاسلامية بعد خروجه من السجن. أخيرًا يشترك طه في عملية تستهدف ضابط أمن الدولة الذي عذبه، فيموت بعد أن ينجح في قتل جلاده.
***
منذ الصفحات الأولى من الرواية، يقدم الراوي وصفاً معمارياً لعمارة يعقوبيان التي بُنيت خلال حكم الملك فؤاد الأول. وبذلك تنتمي للمرحلة الثانية من بناء وسط القاهرة: وقت أن حلت العمارات محل الفيلات ذات الحدائق الكبيرة:
في عام 1934 فكر المليونير هاكوب يعقوبيان، عميد الجالية الأرمنية في مصر آنذاك، في إنشاء عمارة سكنية تحمل اسمه فتخير لها أهم موقع في شارع سليمان باشا وتعاقد لبنائها مع مكتب هندسي إيطالي شهير وضع لها تصميما جميلا: عشرة أدوار شاهقة من الطراز الأوروبي الكلاسيكي الفخم: الشرفات مزدانة بتماثيل لوجوه إغريقية منحوتة على الحجر والأعمدة والدرجات والممرات كلها بالرخام الطبيعي والمصعد ماركة شندلر على أحدث طراز.. استمرت أعمال البناء عامين كاملين خرجت بعدهما تحفة.
أولاً، يمكننا ملاحظة أن عروض الأراضي المقدمة لهاكوب يعقوبيان وافرة ومتنوعة. فاختار إذن أفضل موقع لعمارته. هاكوب يعقوبيان، في الواقع، عهد بالمهمة للمهندس المعماري الأرمني كارو باليان الذي صمم العمارة من ثمانية طوابق بطراز آر ديكو. الوصف الخيالي للعمارة يجعلنا نفهم أن الراوي لا يريد إعطاء توثيق مفصل لعمارة يعقوبيان.
الوصف في بداية الرواية يمثل الحالة العامة لمعظم عمارات وسط المدينة في تلك الفترة. وصف العمارة يجمع عناصر مختلفة من عدة مباني واقعة في وسط المدينة: النوع الأوروبي الكلاسيكي (النيو كلاسيكي)، الزخارف، مواد البناء والابتكارات التكنولوجية.
***
بخصوص النوافذ المزينة بوجوه إغريقية، فهي ممارسة نادرة جداً في مباني وسط المدينة الكلاسيكية والأمثلة عليها قليلة: بعض نوافذ قصر السكاكيني في الحي الذي يحمل نفس الاسم، مبنى النادي الدبلوماسي المصري (نادي محمد علي سابقاً)، ثم مثالان آخران في حي جاردن سيتي. يبدو أن هذين الأخيرين قد ألهما الأسواني لأنه كان يسكن ويعمل في نفس الحي.
***
في نهاية الرواية، في حوار بين زكي دسوقي وبثينة، يؤكد الأول أن العمارة نسخة مطابقة تماماً لعمارة رآها في الحي اللاتيني في باريس. المعلومة غير دقيقة، لأن العمارة لا تشبه تماماً تلك الموجودة في الحي المذكور، لكنها على أية حال تسلط الضوء على استعارة الأساليب الأوروبية التي كانت ممارسة شائعة منذ نهاية القرن التاسع عشر. هذا بوضوح حال عدة مباني في وسط المدينة. عمارة يعقوبيان تُرى كعمل فني يحمل بفخر اسم صاحبها:
“أعمال البناء استغرقت عامين كاملين معمارية خرجت بعدها تحفة معمارية جاوزت كل توقع لدرجة جعلت صاحبها يطالب من المهندس الإيطالي أن ينقش على بابها من الداخل اسمه “يعقوبيان” بحروف لاتينية كبيرة تضاء ليلا بالنيون وكأنه يخلد اسمه ويؤكد ملكيته للمبنى البديع”.
***
العمارة جزء من مدينة كوزموبوليتانية، حيث السكان يمثلون “كريمة” المجتمع ما بين النخب والأجانب: “وقد سكن في عمارة يعقوبيان صفوة المجتمع في تلك الأيام، وزراء وباشوات من كبار الإقطاعيين ورجال صناعة لأجانب واثنين من مليونيرات اليهود (أحدهما من عائلة موصيري المعروفة)”.
الراوي يحرص على ذكر الطبقات المختلفة التي تمثل السكان القدامى لوسط المدينة. مما يذكرنا بدور الأجانب في المجتمع كما شرحنا في بداية الحلقة. في ذلك الوقت، معظم الأجانب عملوا كخبراء أو فنيين من مستوى عال. أخيراً، اليهود، خاصة عائلة موصيري التي اهتمت بالإنتاج إضافة إلى توزيع الأفلام السينمائية.
اقرأ أيضا:
قاهرة يوليو (15): ماذا قالت ضحى عن قاهرة الستينات؟ (2-2)