قاهرة يوليو (15): ماذا قالت ضحى عن قاهرة الستينات؟ (2-2)
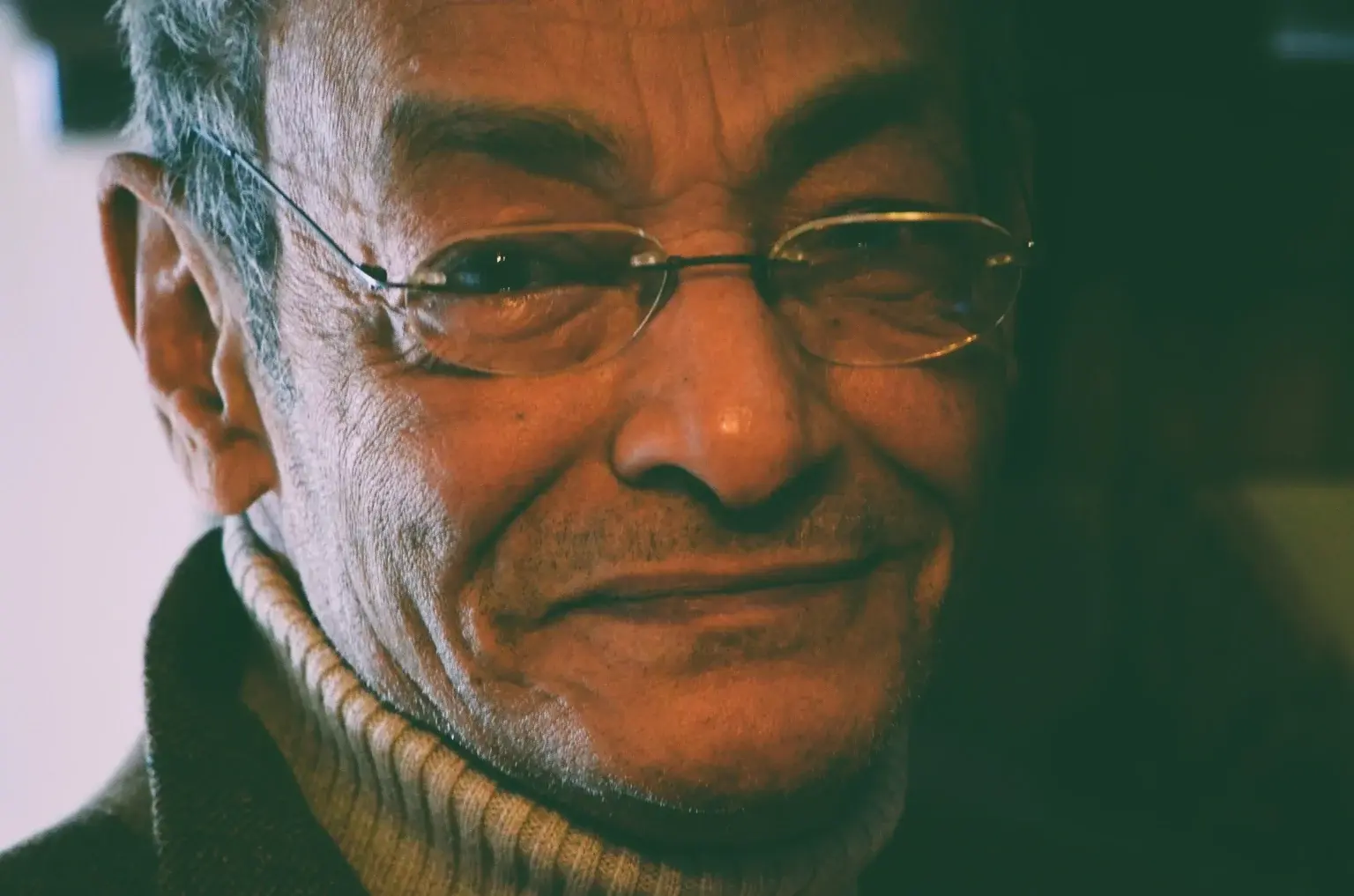
في تحليلنا لرواية قالت ضحى لبهاء طاهر كنا قد اختتمنا الحلقة الماضية بمشهد يبرز التوازي المتضاد بين محل البن المهجور وبين محل سندويتشات الفول في ميدان “سليمان” حسبما ارتأى للراوي أن يسميه، أما بخصوص تشبيه تجمع الزبائن أمام محل الفول بالمظاهرة فنرى أنه تشبيه دال: فليس الأمر يتعلق بالعدد الكبير فحسب وإنما لفظ المظاهرة هنا ليس ذي صفة سياسية أو اجتماعية وإنما تعبر عن حاجة أساسية: الطعام ولا عجب حيث أن توقف الحياة السياسية في مصر خلال العصر الناصري لم يكن يسمح إلا بهذا النوع من المظاهرات!
أما عن أغنية الراديو فاختيارها له دلالة أيضا، “الهوان وياك عزة” هي أغنية قديمة أداها محمد عبد الوهاب عام 1932. ومن عنوانها تتناول الأغنية حالة من حالات عاشق يعاني الهجر لكنه راضٍ. وكأن المؤلف أراد، باختياره لهذه الأغنية، أن يعكس حالة معظم المصريين خلال الستينيات: يرزحون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والعواصف سياسية لكنهم يستقبلونها بارتياح، مليئين بالأمل رغم كل شيء في شعارات العصر: العزة والكرامة ومحاربة الإمبريالية. قبل مشهد المظاهرة أمام محل السندويشات، تستحضر الرواية بحزن استبدال التمثال القديم لميدان سليمان باشا بتمثال طلعت حرب: “ووصل إلى من راديو مفتوح على آخره في كشك للسجائر عبد الحليم حافظ وهو يغني ‘أبو زيد زمانك، أبو زيد زمانك وحصانك الكلمة والخدمة الوطنية’، وواجهني تمثال طلعت حرب في الميدان بديناً وفخيماً وكانوا قد أزالوا تمثال سليمان الفرنساوي ووضعوا مكانه طلعت حرب”.
** **
مرة أخرى، يقوم الراوي بحذف لقب الباشا من أسماء التمثالين مكتفيًا بذكر اسمائهما المعروفة في كتب التاريخ “سليمان الفرنساوي” و”طلعت حرب”.
يبدو أن مبعث تقدير الراوي لتمثال طلعت حرب كونه جديداً فقط. أما الأغنية المذكورة فهي واحدة من الأغاني الوطنية التي أداها عبد الحليم حافظ، وهي تتناول مسئولية تمثيل الشعب بعضوية الاتحاد الاشتراكي العربي. اختيار الأغنية “المسؤولية”، والجملة المقتبسة منها، له أيضًا في رأينا دلالة: ابرزت الجملة تشبيهاً لأعضاء الحزب الواحد في البلد، بصفتهم ممثلي الشعب، بالأبطال الأسطوريين الشعبيين كأبي زيد الهلالي وهو ما نعتبره مبالغة في وقتنا هذا لكن ذلك لم يخرج عما عهده العقل الجمعي المصري من حماس الفترة الثورية في جمهورية يوليه.
تتواصل مشاهدات الراوي للميدان ثم يعود بنا إلى المالك الأجنبي لمحل القهوة الصغير:
“وكنا نقف في محل القهوة الإكسبرسو الصغير الخالي دائماً في ذلك الوقت من الظهيرة، وكان صاحبها الخواجة يجلس أمام مقعده العالي أمام آلته الحاسبة وهو ينظر في شرود إلى الميدان وإلى طلعت حرب”.
الأجواء الحزينة تغمر المحل الصغير المهجور تقريبًا من زبائنه بعكس مظاهرة محل سندويشات الفول فيما يربط الراوي كلمة “خواجة” الشائعة في اللهجة العامية المصرية لوصف الأجنبي. ونعتقد هنا أن كلمة “خواجة” تُستخدم للتأكيد على الطابع الأجنبي للمالك المحاصر بمظاهر التمصير الجاري: استبدال التمثال وتغيير اسم الميدان بعد مرور قرن من الزمان، والحشد الصاخب أمام محل سندويشات الفول، وأصوات الراديو المرتفعة التي تصدح أحيانًا بالأغاني الوطنية. في حال مثل هذه، لا يملك “الخواجة” سوى النظر إلى كل ما يحدث حوله، ثم الشرود أو السفر ذهنيًا إلى الزمن المنقضي الذي ينتمي إليه عالمًا بحقيقة عدم عودته٠ نستطيع أن نستنتج أن غياب الوجود الأجنبي قد ترك بصمته بقسوة على المشهد الحضري لوسط البلد وعلى الحياة اليومية لشوارعه رغم النجاح النسبي لعمليات التمصير.
كل شيء يغادر
“كنا نسير معا في شارع قصر النيل بعد أن خرجنا من العمل عندما توقفت ضحى فجأة في الطريق ممتقعة الوجه وتمتمت بصوت لا يكاد يُسمع ‘حتى هذا؟’ كانت تقف أمام فاترينة زجاجية خالية عليها لافتة ‘المحل للبيع بالجدك’ وأخذت ضحى تهز رأسها وتقول بصوت خافت ‘حتى سيستوفاريس سيرحل من هنا أيضاً؟’ ولم أقل شيئاً ولكن ضحى التفتت إلى فجأة وكأنني أتهمها بشيء وقالت ‘ليس لأنه محل فراء. أنا لا يهمني الفراء ولا ألبسه ولكن انظر. انظر إلى الشارع وقد خلا من ذلك المعطف الفضي الذي كان حتى الأمس ينير هذه الفاترينة في هذه الناصية؟“
ضحى التي تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية مصدومة من أن محل الفراء يُباع بالجدك، إذ لم يكن ليصمد بعد رحيل أصحابه الأجانب عن البلاد واحلالهم بالطبقات “الفاتحة”. لا نشك أن فرع سيستوفاريس بالقاهرة، وهي العلامة المشهورة للفراء التي لها عدة فروع في المدن الأوروبية، قد تم تأُميمه خلال الستينيات، إلا أنه وبحسب علمنا لا يوجد لدينا ما يثبت ذلك أو ينفيه…الذي يعنينا هنا هو أن المحل المعروض للبيع بأثاثه ومعروضاته يمثل بالنسبة لضحى، التي عايشت العصر الذهبي لوسط البلد الكوزموبوليتانية، جزءا من ذاكرة الشارع، أو بتعبيرها هي، عضوا في جسد الشارع. بعكس الراوي، الذي لا ينتمي للطبقة الاجتماعية لضحى، وبالتالي لم يدر ما يقول سوى نظرة فسرتها ضحى بالاتهام فقررت الدفاع بإيضاح رؤيتها للعلاقة بين الشارع والمحال الكائنة فيه والمعروضات داخله.
إن الأمر ببساطة يتلخص في أن الفراء والمعطف الفضي لا يبدوان بضائع مرغوبة من المستهلكين الجدد ومن ثم فقد آن لهذه البضائع، مع المحال التي تحتوي عليها، أن تلحق بركب الرحيل الصامت للنخب والأجانب من وسط البلد ومن القاهرة عمومًا٠ لكن على أية حال فإننا نلاحظ أن الراوي يؤكد على كوزموبولتانية المدينة رغم التمصير وذلك باستخدام المصطلحات الأجنبية مثل كلمة ڤاترينا الإيطالية وكان من الممكن احلالها مثلا بترجمتها العربية كواجهة المحل أو ما شابهها.
** **
تستمر تأملات ضحى التي تستحضر العصر المنقضي: “وأشارت ضحى بيدها إلى ناصية شارع الشواربي وقالت في مكان هذه العمارة، هناك كان مقهى واجهته من الأشجار، كنت تعبر المدخل وتنزل سلمتين أو ثلاث سلالم فإذا بك فجأة تترك مدينة الطوب والحجر وتدخل في جنة من الأزهار والأشجار، ممراتها مرصوفة بالرمل النظيف وموائدها تتناثر في مقاصير وسط الأشجار. وكنت آتي إلى هنا مع زميلاتي أيام المدرسة وكنت أحب أشجارها، بل أظن أنه كانت هناك شجرة مانوليا تتوهج في الربيع بأزهارها الحمراء، لست متأكدة هل كانت شجرة المانوليا هناك أم أنا أحلم أنها كانت هناك. ولكن منذ أن هدموا هذا المقهى وبنوا هذه العمارة القبيحة مكانه لا أنظر إلى هذا الجزء من الشارع تماماً كما تتجنب النظر إلى شخص مبتور الذراع. هل تفهمني؟ كيف يسمحون بذلك؟ هل تفهمني؟“
الشواربي هو شارع صغير يربط بين شارعين كبيرين: قصر النيل والمناخ (حاليًا شارع عبد الخالق ثروت). كان يُعرف بهدوئه وبوجود بعض الفيلات المرموقة على جانبيه. إلا أن هذه الأخيرة قد تم احلالها ضمن عملية التمصير: على سبيل المثال، فيلا الشواربي باشا تحولت إلى مقهى. والفيلا رقم 5 في هذا الشارع، التي شغلتها السفارة الأمريكية (1905-1909)، هُدمت واستُبدلت بمبنى مكاتب.
** **
في الفقرة السابقة، تتقاطع الذكريات مع الأحلام وتختلط بالحقائق. ضحى تصف مقهى حديقة لا يبدو لنا أن له وجودًا بالفعل رغم الوصف الذي يؤكد على أهمية المكان وتميزه بتكامله مع الطبيعة. مدارك ضحى واسعة ومتنوعة مقارنة بالراوي الذي عادةً ما يكون مستمعاً محاولاً فهم ما تقول. تعتبر ضحى أن الأشجار أيضاً أعضاء حقيقيين في جسد الشارع، تماما مثل المعطف الفضي في فاترينة سيستوفاريس الذي تم بيعه. اختفى المقهى-الحديقة وظهر مكانه مبنى “قبيح” – على حد وصفها- لا شك في أنه ينتمي إلى الطراز الحديث الذي أصبح سمة من سمات عمارة الستينيات في مصر والتي ستتناولها ضحى بالنقد والتعريض لاحقًا. وبصفة عامة، نلاحظ أن ضحى والراوي يستخدمان ضمير الجمع (هم) للإشارة إلى الذين حولوا وجه المدينة تحديدًا وسط البلد. هؤلاء، الذين تنتقدهم ضحى كثيراً، هم بالضرورة النظام الحاكم: المسؤول الأول عن عمليات الهدم أو “التشويه” حسب تعبير ضحى.
** **
إن الذكريات والتأملات التي تستحضرها ضحى مغلفة بالحزن والغضب حتى أن ضحى تتجنب الذهاب إلى هذه الشوارع “المشوهة”. فيما يتفاعل الراوي قليلاً مع هذه التأملات لأنه لا يشارك ضحى نفس المشاعر ولا نفس الثقافة (أنه لا يعرف مثلًا ما هي المانوليا). من هنا وهناك نفهم أن التاريخ المجيد لوسط البلد، المجهول تقريباً للراوي، قد انكشف له على هيئة الذكريات والملاحظات التأملية لضحى والتي يجد نفسه دائماً عاجزًا عن التعليق عليها أو انتقادها. أما ضحى، فهي واعية بالفروق الثقافية والاجتماعية بينها وبين الراوي: فنجدها تكرر سؤال “هل تفهمني؟” لتطمئن نفسها. لكن يبدو أن حيرة الراوي وتردده ثم عدم ادراكه الواقع من حوله يسيطروا على المشهد:
“قلت لنفسي أنا لا أفهم ما يحدث في البلد، أنا لا أفهم ضحى. أنا أحبها فقط، أنا لا أفهم نفسي ويحسن أن أكف عن التفكير في أي شيء”.
تتعدى الانتقادات العديدة لضحى من هدم واختفاء الأماكن ذات القيمة في وسط البلد إلى نقد عمارة الحداثة في المباني الجديدة المشيدة في وسط البلد والتي تُعتبر أكبر معالم قاهرة يوليه. تناولت ضحى بالنقد فندق هيلتون في ميدان التحرير:
“كانت تلتفت برأسها بعيداً عني وهي تنظر في شرود إلى مدخل الهيلتون وقالت فجأة بصوت غاضب : لماذا وضعوا هذا المبنى هنا؟ لماذا بنوا هذه التورتة الزرقاء بجوار المتحف؟ هذا تدنيس للمكان، فاجأتني ملاحظاتها، فنظرت إلى المدخل وعليه النقوش الهيروغليفية من الثعابين والطيور والخطوط المتعرجة، وكأنها كانت تتابع نظري فقالت: وهذه النقوش تدنيس للكتابة القديمة… الكتابة كانت شيئاً مقدساً لا زينة.. لا.. لا”.
** **
الاستعارة الجريئة للصورة التورتة الزرقاء تؤكد على ضخامة الفندق وعدم ملاءمة موقعه في ميدان التحرير كونه ملاصقاً للمتحف المصري الذي يمثل حضارة مصر القديمة٠ لا يبدو، حسب ضحى، أن مبنى الهيلتون متناغماً مع المتحف لدرجة اعتبار ضحى إياه إهانة للتاريخ. وبالرغم من النقوش البارزة المستوحاة من الكتابة الهيروغليفية على واجهة الفندق، تُعتبر هذه حسب ضحى عناصر مسيئة لأنها تستخدم رموز الكتابة الهيروغليفية دون فهم حقيقي لأهدافها المقدسة.
أما الراوي، المأخوذ عادة بما تقول ضحى، فإنه يبدأ في تأمل المبنى للمرة الأولى؛ فهو لم يفكر قط في علاقة المبنى الجديد بسياقه، أو علاقة النقوش البارزة بالكتابة المصرية، رغم أنه يمر أمامه يومياً كونه يعمل في وسط البلد.
** **
قدمت “قالت ضحى” صورة بانورامية لتحولات القاهرة في الستينيات، من خلال عيني شخصيتين تنتميان لزمنين مختلفين ولقاهرتين مختلفتين: تتنمي ضحى للعصر المنقضي البائد حيث قاهرة إسماعيل وأما الراوي فينتمي للعصر الحديث حيث قاهرة ناصر أو قاهرة يوليه. تحمل ضحى الأرستقراطية ذاكرة المدينة الكوزموبوليتانية وتشهد اندثارها بألم، بينما الراوي الموظف يعيش حاضر المدينة دون أن يعنيه الصورة التي كانت عليها قبل أو دون أن يدرك عمق الفقد الذي استولى على المدينة في سنوات معدودات. الرواية لا تؤرخ للأحداث السياسية فحسب، بل لروح المكان وذاكرته، وتتعرض لصراع الهويات في مدينة لا تكف عن التحول خلال حقبة فاصلة في تاريخ مصر الحديث تصطدم فيها الحداثة بالتراث، وتنتج صراعاً لا تزال أثاره حاضرة في قاهرة اليوم.




