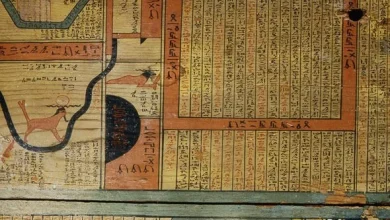«فاطمة محمد»: لم أستبعد فوزي بالمركز الثالث والقراءة لم تٌعرًفني بالتراث فقط بل قربتني منه أولا

تواصل «فاطمة محمد عبد الرحيم»، خريجة كلية الدراسات الإنسانية قسم التاريخ، رحلتها العلمية بدراسة دبلومة الإرشاد السياحي بجامعة حلوان، بعد أن حققت المركز الثالث في الموسم الرابع من المشروع الوطني للقراءة. تسعى فاطمة إلى أن تكون مرشدة سياحية تقدم التراث المصري بروح معاصرة، وفي الوقت نفسه تنفتح على الشرق الأقصى عبر تعلم اللغة الإندونيسية، مدفوعة بشغفها تجاه قيم وأخلاق تلك الثقافة. هدفها أن تكون جسرا يصل بين التراث المصري العريق والمجتمع الإندونيسي، مؤكدة أن الإصرار والمعرفة قادران على صناعة التميز مهما كانت التحديات.
رحلة مع القراءة والتراث واللغة
لم تتشكل خبرتها بين الكتب وحدها، بل على أرض الواقع أيضًا؛ إذ أسهمت في الخدمة المجتمعية داخل متحف الفن الإسلامي ومتحف المركبات الملكية، حيث لامست التراث المصري حيًّا وملموسًا. هذا التوازن بين القراءة والمعايشة العملية ثقل شخصيتها وجعلها تحمل رؤية شاملة تنسج الخيط بين الماضي والحاضر. ولأن الشغف لا يكتمل إلا بالمشاركة، أطلقت فاطمة قناتها على يوتيوب تحت اسم “حكاوي فاطمة”، لتشارك من خلالها قصتها مع الكتب والتاريخ، ولتفتح نافذة تعبر منها حكايات التراث المصري إلى قلوب المهتمين بالثقافة الإندونيسية.
رحلتها مع المشروع الوطني لم تكن سهلة. ففي الموسم الثالث توقفت عند التصفيات الأولى، لكن تلك التجربة لم تكن خسارة، بل أرضًا صلبة بنت عليها معرفتها. قرأت بعمق أكبر، واحتكت بمجتمعات وثقافات متعددة، ما منحها ثقةً ونضجًا انعكسا أمام لجان التحكيم في الموسم الرابع. واليوم تقف فاطمة شاهدة لتروي لنا في هذا الحوار كيف أن القراءة ليست مجرد هواية، بل مشروع حياة، وأن التراث المصري ما زال بحاجة إلى أصوات شابة تحمل رسالته للعالم، وتؤمن أن الثقافة لا تعرف حدودًا.
-
ما الذي شجّعك على المشاركة في المشروع الوطني للقراءة منذ البداية؟
منذ المرحلة الثانوية، كنت أميل إلى القراءة، لكن توقفت عند التحاقي بالجامعة لانشغالي بعالمها الجديد. ثم رغبت في العودة إليها، ولم أجد الدافع المناسب حتى وجدت المشروع الوطني للقراءة. أعجبني تنظيمه، وكان الموقع الإلكتروني بسيطًا في التسجيل ويُظهر الهدف بوضوح، ما شجعني إلى العودة للقراءة من جديد.
-
ما شعورك عند إعلان فوزك بالمركز الثالث؟ وهل توقعت ذلك؟
شعرتُ بسعادة كبيرة، خصوصًا بالكلمات التي قالها مقدم الحفل أيمن الجراح، وما ذكرته لجان التحكيم عن المراكز الثلاثة الأولى، فقد أسعدني ذلك كثيرًا. لم يكن الفوز مستبعدًا بالنسبة لي، لكنني لم أُعطِ نفسي إحساسا مسبقا به. كنت سأكون سعيدة حتى لو حصلت على مركز بعد السابع، ومع ذلك لم أستبعد أن أكون الثالثة، لكنني لم أشأ أن أؤكد ذلك داخلي حتى أبقى متقبلة لأي نتيجة.
-
هل واجهتِ صعوبة في اختيار الكتب خلال مراحل المسابقة؟
نعم، واجهت صعوبة كبيرة في الموسم الثالث، وأعتقد أن هذا كان سببًا في عدم تأهلي؛ إذ إن معظم الكتب كانت علمية، مما قلل من التنوع. كما أن الكتب العلمية البحتة يصعب النقاش فيها مع لجنة التحكيم. لكن في الموسم الرابع كنتُ أكثر استعدادًا؛ إذ قضيت عامًا أقرأ في مجالات متنوعة، كما أن مسابقة القراءة الحرة التي نظمتها الجامعة تزامنت مع المشروع الوطني. فقد حددت الجامعة خمسة كتب تراثية ذات قيمة عالية، فقلت لنفسي: إن نجحتُ فيها فخير، وإن لم أنجح سأضعها ضمن كتب المشروع الوطني للقراءة.
كان من بينها الإمتاع والمؤانسة الذي بدت لغته صعبة في البداية، لكني استعنت بتسجيلات على يوتيوب أستمع إليها في المواصلات، ثم أعود لقراءته مساءً. ومع التكرار أصبحت الألفاظ مألوفة، مما سهَّل علي القراءة والتلخيص. الكتاب في نحو 450 صفحة، أنهيته خلال شهر ونصف تقريبًا، وقد أضاف لي الكثير رغم الجهد المبذول. أما كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى فكان أسهل لغةً لكنه طويل، وقد أخذ وقتًا في قراءته. غير أن هذه التجربة أفادتني كثيرا في المشروع وأثرت مدونتي وفتحت أمامي أبوابًا لفكر جديد لم أتعرض له من قبل، إذ قرأت في تسعة مجالات مختلفة.
-
هل تغير أسلوب قراءتك بعد الفوز من حيث التحليل واختيار الكتب؟
التغيير لم يبدأ بعد الفوز، بل منذ تصفيات الموسم الرابع. فقد شعرت أنني مندمجة في عالم القراءة والتحكيم وأسئلة المصفوفة. تجربة التحكيم في تصفيات الجمهورية كانت ممتعة للغاية حتى إنني نسيت النتيجة وبدأت أستعد مباشرة للموسم الخامس. صرت أقسم المجالات، وأقرأ واضعة أمامي أسئلة المصفوفة، وأحرص على معرفة سيرة المؤلف وأعماله الأخرى، إلى جانب الأفكار الرئيسة والفرعية. وقبل إعلان النتيجة كنت قد أنهيت قراءة عشرة كتب كنت أنوي المشاركة بها في الموسم الخامس. كان هذا الاستعداد أكثر وعيًا وعمقًا.
-
إذا قدمت نصيحة لمشارك في الموسم الخامس، على ماذا تنصحينه بالتركيز؟
أن يهتم بتنوع المجالات، وألا يقتصر قراءته على الكتاب فقط، بل يحيط نفسه بما حوله من سيرة المؤلف وخلفيته وما كُتب عن الكاتب والكتاب والإطلاع على فكره بشكل كامل. كما أنصح بألا يخاف من لجنة التحكيم؛ فهي للنقاش والتعلم وليست للحكم.
-
كيف ساعدتك القراءة في تقديم التراث بصورة أبسط وأعمق؟
القراءة لم تساعدني في تقديم التراث فقط، بل عرفتني به أولًا. فقد جعلتني أتعرف على الهوية المصرية والتراث الإسلامي، ومنحتني أرضًا صلبة أبني عليها أفكاري وشخصيتي. ومن ثم صرت أعبر عن التراث من خلال الفكر والوعي الذي كوّنته القراءة بداخلي.
-
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه القراءة في تعريف السائح بتاريخ مصر؟
المرشد السياحي يُقال له إنه لا ينبغي أن يتوقف عن التعلم والقراءة. وهذا صحيح، لكن القراءة لا يجب أن تقتصر على التاريخ فقط، بل تشمل مجالات شتى مثل علم النفس، والاجتماع، وثقافات الشعوب. خلال عملي التطوعي في المتحف المصري، لاحظت أنّ السائحين لا يأتون من أجل المعلومة وحدها، فهي متاحة في الكتب وغالبًا قد أطلعوا عليها مسبقًا، بل يأتون لاكتشاف الثقافة والعادات والدين، ويريدون أن يفهموا دور المعلومة التاريخية في المجتمع. هنا يتصدر المرشد السياحي هذا الدور، لذا يجب أن تكون لديه معرفة موسوعية، وسرعة بديهة، ولباقة في الرد على مختلف الأسئلة. وبالتالي القراءة ضرورية في التاريخ وغيره من المجالات.
-
من خلال خبرتك.. ما المكان الأثري أو المتحف الذي تشعرين أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي؟
أرى أن الوزارة تركز على الأماكن البارزة ذات القيمة التراثية والتاريخية، مثل شارع المعز، حيث نجد بعض الآثار مستغلة وتحظى بالاهتمام والترميم، بينما لا تزال أخرى مهملة وغير مستغلة. وهناك مشكلة يعاني منها الأثريون حاليًا، وهي أن أي أثر لم يُبرز في مشروعات الترميم لا يسجل كأثر رسمي، رغم قيمته.
-
كيف ساعدتك تجربتك في المتاحف على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي؟
الجامعة لا توفر لنا تدريبًا عمليًا، بل المتاحف هي المسؤولة عن ذلك. يقتصر دور الجامعة على ترشيح بعض الطلاب البارزين، وفي كليتي لم يكن هذا الدعم متوفرًا، فكنا نتقدم بأنفسنا للتدريب. أول تدريب حصلت عليه كان في متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب، وكان بسيطًا نسبيًا. بعدها التحقت بتدريب في المتحف المصري بالتحرير، وكان أكثر كثافة وصعوبة، لكنه أضاف لي كثيرًا. هذه التجارب جعلتني أتعرف على أسس التعامل مع السياح، وتبادل الأفكار والنقاش بلغات وثقافات مختلفة. مما ساعدني على الدمج بين العملي والنظري.
-
ما أكثر جانب من التراث المصري لفت انتباهك خلال دراستك للإرشاد السياحي؟
التراث الإسلامي، وخاصة العمارة. فقد فقدنا جزءًا كبيرًا من قيمتها، إذ إن المباني الحالية لا تمتلك روحا أو هوية بصرية ولا توفر الراحة بالمعنى الذي كانت عليه العمارة الإسلامية. تلك العمارة كانت ذات طراز يمنح الناس متنفسًا، فيجلسون فيه حتى من غير عمل، وهذا للأسف لم يعد موجودًا. كما أنها كانت متقاربة في العالم الإسلامي كله مع اختلافات بسيطة، وأتمنى أن تعود مرة أخرى. بل إن حلمي أن أمتلك مكانًا مصممًا على هذا الطراز لما يحمله من جماليات وفن.
-
هل يمكن أن تصنف العمارة الحالية تراثا في المستقبل؟
لا، لأن معظمها يفتقر إلى الروح والهوية البصرية، وهي موجودة في كل أنحاء العالم. الاستثناء هو البيوت الريفية المنقوشة في بعض المناطق والمصممة على طرز معينة، إذ تحمل طابعًا خاصًا يمكن أن يُصنف يومًا ما كتراث، لأنها مميزة ومعاصرة في نفس الوقت.
-
هل ترين أن السياحة الثقافية في مصر نالت حقها من الاهتمام؟
ما زالت بحاجة إلى تطوير. لدينا آثار ومعالم تتحدث عن نفسها، ومع ذلك نركز عليها ونبرزها رغم أننا نملك مواقع أخرى يمكن أن تكون عوامل جذب سياحي لم نولها الاهتمام الكافي. نحن نركّز على ما يسوّق نفسه طبيعيًا ونهمل ما يحتاج لتسويق.
كما أن الأنشطة الفنية والثقافية التي تُقام داخل المتاحف يمكن أن تكون عامل جذب مهم، فهي تخلق تلاحمًا بين الأثر والفن، لكنها أيضًا لا تُنفَذ بالجودة الكافية أو بالشكل الذي يبرز إمكاناتها.
-
خلال تجربتك في المتحف الإسلامي، ما الرسالة التي شعرتِ أن التراث المصري يوجّهها للعالم؟ وهل لاحظتِ حاجة الزوار إلى ثقافة قرائية معينة لتقدير المعروضات؟
هذا العام تحديدًا شعرتُ بالعزة والفخر. لم أكن أتخيل قبل عملي في المتحف أن أشعر بهذا القدر من الانتماء. التاريخ الإسلامي في مصر ليس مختزلًا فيما يراه الناس اليوم، بل أعمق وأكبر بكثير، وهو حلقة أساسية في تقدم البشرية جمعاء. لذلك من المهم أن يكون الشخص الذي يقدم المعلومة مؤمنًا بها ومشبعًا بهذا الوعي حتى ينقلها بإخلاص. تراثنا يبعث رسائل عن هويتنا وعزتنا.
-
لماذا اخترت اللغة الاندونيسية؟ وهل هناك جوانب من الثقافة المصرية مرتبطة بالثقافة الإندونيسية؟
ما يجمعنا بهم هو الإسلام، وهذا عامل مهم يجعل التشابه أكثر مما نتصور. لكن ثقافتهم مختلفة عن ثقافتنا؛ فنحن شعب شرق أوسطي في إفريقيا، وهم شعب جنوب آسيوي. حين بدأت عملي في متحف الفن الإسلامي، كنت أمر بمرحلة من التشتت الفكري، وبدأت أحتك بالأجانب وأدخل في نقاشات جعلتني بين نقيضين. في الوقت ذاته جاءتني فرصة المشاركة في مسابقة القراءة الحرة، وكانت كتبها مختلفة عن طريقة تفكيري، فكان ذلك تحديًا.
لاحقًا حينما احتككت بالإندونيسيين، وجدت أن مجتمعهم -رغم أنه إسلامي- يعاني من مشكلات مختلفة تمامًا عن مجتمعنا. هذا جعلني أشعر بالسكينة، لأننا نرى أنفسنا منبع الإسلام، بينما هناك مجتمعات إسلامية غير عربية لا نلتفت إليها، ونركز فقط على الغرب. لكن المقارنة بين مجتمعين إسلاميين بخلفيات ثقافية مختلفة أبرزت لي الفروق الثقافية والمجتمعية الجوهرية بيننا، رغم ارتباطنا بدين واحد.
-
لو أتيحت لك فرصة تقديم عرض للثقافة المصرية في إندونيسيا، أي عناصر تختارين لتمثيل مصر؟
إن كان العرض موجّهًا للفئة المسلمة والمعاهد الدينية، سأركز على التراث الإسلامي لمصر والأزهر الشريف وعلمائه.
أما إن كان موجهًا للفئات الأخرى، سأعرض الفنون الشعبية التقليدية، مثل الأزياء لما تحمله من تنوع. فمصر تمتاز بتنوع واسع في الفنون، ورغم أن لديهم أيضًا تنوعًا كبيرًا في إندونيسيا، إلا أنه ليس بالثراء نفسه. لذلك سيكون جميلًا أن نعرض ثقافتنا بما تحمله من طابع مميز.
-
كيف يمكن توظيف ما اكتسبتِه من المشروع الوطني للقراءة في رحلتك لتعلّم اللغة الإندونيسية وبناء خطاب ثقافي مزدوج يربط بين التراث المصري والوعي القرائي الإندونيسي؟
من أحلامي أن تُترجم العربية والإندونيسية مباشرة من وإلى بعضهما دون وسيط اللغة الإنجليزية. فالإندونيسيون، وبينهم كثير من المسلمين، يدرسون العلوم الشرعية وتاريخ العرب، لكن اعتمادهم في ذلك الإنجليزية يسبب مشكلات كثيرة. هم يستحقون أن يترجموا من العربية مباشرة. ويتجسد الخطاب الثقافي هنا أولًا في الترجمة، وثانيًا في إبراز المجتمعات المسلمة غير الناطقة بالعربية، حتى نحصر نظرتنا في الغرب وحده كنموذج. فالمجتمعات الإسلامية الأخرى تعكس قيمًا وتجارب مختلفة، ورؤيتها تساهم في تكوين وعي أوسع.
ثالثًا، يجب أن يكون هناك وعي متبادل بين الثقافتين، خاصة أن بعض التصورات في المجتمع الإندونيسي بحاجة إلى تصحيح، إذ ينظرون إلينا أحيانا من زاوية مقاربة للنظرة الغربية، بينما نحن بالكاد نلتفت إليهم. لذا فإن بناء جسر ثقافي مباشر بين البلدين مهم جدًا.
-
يعتمد المشروع الوطني للقراءة على التحليل النقدي والقدرة على استنباط المعاني من النصوص، بينما يقوم الإرشاد السياحي على قراءة الحضارة من خلال الآثار والرموز البصرية. فكيف يمكن توظيف أدوات القراءة النقدية التي اكتسبتها في صياغة خطاب إرشادي يجعل السائح يقرأ التراث المصري بقلبه وعقله معا؟
يتطلب ذلك أن يكون المرشد السياحي قد استوعب الثقافة التي يتعامل معها، وفهم طريقة تفكير أصحابها، ليقدم تاريخ بلده وتراثه أو ثقافته بالأسلوب الذي يثير اهتمام الزائر ويصل إليه بعمق.
-
ولو أتيح لك تأسيس مبادرة، هل ستكون مرتبطة بالقراءة، أم بالإرشاد السياحي، أم بالثقافة الإندونيسية، أم بدمجها جميعًا؟
ستكون مرتبطة بالقراءة، وقد كان لدي بالفعل فكرة مشروع بهذا الخصوص لكنه لم يكتمل.
أما الإرشاد، فقد أصبح موجها للمصريين بشكل متكرر، فيه الصالح والطالح، بينما إذ وُجه للسياح فسيكون أقرب إلى العمل المهني لا إلى المبادرة. وبالنسبة للثقافة الإندونيسية، فهي تخص مجتمعًا له خصوصيته، ولا أظن أن بإمكاني أن أكون رائدة فيه، وإن كان من الممكن أن تكون لي فيه كلمة مسموعة. أما إن كانت المبادرة موجهة إلى المصريين، فلم يخطر في بالي مشروع بعينه، لأن المجال واسع جدًا.
لذلك، أرى أن القراءة هي الأنسب. وقد اقترحت مبادرة تقوم على تنظيم ورش عمل للسيدات والأطفال بجانب الأماكن الأثرية، بحيث يتم اختيار كتاب محدد يُشرح في ثلاث محاضرات، بالتوازي مع ورش للأطفال. وتُقام هذه المبادرة شهريًا في موقع أثري مختلف، لتجمع بين القراءة والثقافة والتراث.
اقرأ أيضا:
ضيوف النسخة السادسة من ملتقى المناخ: لا بد أن تكون الأولوية لكوكب الأرض
«كريم الشافعي»: مشروع «تمارا» واجه تحديات كبيرة ورممنا 15 عقارا
بطل قومي وجندي يعاني.. «الفلاح المصري» في لوحات الفن التشكيلي وكتب الأدب