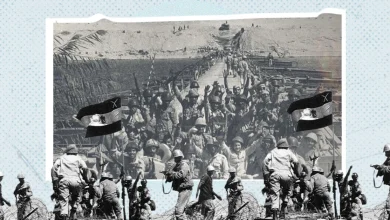جمال الغيطاني: الذاكرة هي الوجود الحقيقي للإنسان

جرى هذا الحوار مع جمال الغيطاني عام 2005، كان جزءا من مشروع كبير بعنوان «جمال الغيطاني يتذكر»، ولكنه لم يكتمل للأسف. هذه مقاطع من الحوار.
-1-
رغم أن جمال الغيطاني ولد في اليوم الذي أعلن فيه رسميا توقف الحرب العالمية الثانية، إلا أن صاحب “الزيني بركات” لم يتوقف عن خوض المعارك والحروب، الفعلية والمجازية. حروب كلفته الكثير، شهورا من التعذيب في معتقلات عبدالناصر، ولم يكن قد تجاوز العشرين، وست سنوات كاملة على الجبهة المصرية مراسلا حربيا متطوعا لجريدة أخبار اليوم، كان يواجهه الموت فيها كل ساعة.
فصل من العمل في بداية حكم السادات، ثم تجميد من الكتابة الصحفية طوال سنوات السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات، وحملات تشويه بسبب مواقفه. باختصار مسار حياة ثري.. لا يندم على شيء فيه (باستثناء العمل في الصحافة الثقافية)… يضحك: ” لا أنكر أنني استفدت كثيرا من العمل الصحفي، فالخبرات التي اكتسبتها من عملي لسنوات على الجبهة لا يمكن أن أنكرها. ولكن عندما انتقلت للعمل في الصحافة الثقافية، بدأت حملات التشهير ضدي).
يتذكر الغيطاني عندما حصل على جائزة الدولة التشجيعية، نشر الخبر في الجريدة التي يعمل بها بدون اسمه، لاحظ رئيس التحرير وقتها، موسى صبري الأمر، فأوقف الطبع، ووضع صورته بدون أن يوضع اسمه. “كنت محسوبا على الشيوعيين.. وكان المسؤول عن الصفحة الثقافية في الأخبار قد وضع قائمة بأسماء كتاب الستينيات كممنوعين من النشر”. كانت مهمة الغيطاني، عندما تولى مسؤولية الصفحة الثقافية بالأخبار شاقة: “لم يعد جيل الستينيات شابا كما كان يقال وقتها، وليس هناك أسباب حقيقية لمنعهم من النشر”.
سنوات السبعينيات هي أقسى فترات حياته.. بعد أن توقفت الحرب وبدأت مفاوضات الكيلو 101، شعر أن هناك ريحا أخرى بدأت تهب. دخل على رئيس التحرير موسى صبري، وطلب إعفاءه من العمل كمراسل حربي سأله صبري: تحب تروح فين؟ وأكمل: “قسم الدراسات”. لم يكن هذا القسم سوى “جراج للمعارضين” غير المرغوب أن يكتبوا، وضم عادل حسين، جمال بدوي، ومصطفى طيبة، ومجموعة أخرى تم تصنيفهم كيسار، ولم يكن مطلوبا أن يكتبوا.
“كانت فترة صعبة، ربما أكثر من الفترة التي سجنت فيها”، يقول الغيطاني: “في عام 1978 اضطررت أن أذهب إلى طبيب نفسي”. يضحك: “تعرف أننا كصعايدة نتحمل الألم، ولا نذهب إلى الطبيب إلا نادرا، فما بالك بأن تذهب إلى طبيب نفسي لتحكى له”.
كانت البداية عندما استيقظ الغيطاني مفزوعا، متوهما أنه يموت، ذهب في الصباح إلى طبيب أمراض قلب أخبره أنه لا يعاني من أي مشكلات، فقط يحتاج إلى طبيب نفسي. الطبيب النفسي أخبره أنه يعاني من حالة “اكتئاب حاد”.. يعلق الغيطاني: “منذ تلك الليلة التي توهمت فيها إصابتي بالقلب.. أنا أحتضر منذ ثلاثين عاما”.
لم يكن اكتئاب الغيطاني وقتها نتيجة مشاكل شخصية، بل مشكلات عامة، “وطن يبدأ في التحلل ببطء”، يقول: “إذا أردت أن تفهم جيل الستينيات، فالمفتاح الهام لفهمهم هو أن “القضايا العامة هي قضايا خاصة”. يتذكر: “تصور، كنت أبكى عندما كانت فيتنام تضرب.. وعندما كنت في أحد التنظيمات اليسارية، كانت اجتماعاتنا تبدأ بسؤال من الرفاق لي: “إيه الموقف يا رفيق فريد؟”( فريد هو اسمه الحركي داخل التنظيم)”، وكنت أشرح لهم ما يجري هناك، بالتفصيل”.
ولكن هل استمر الشعور بأن (العام خاص) بعد كل هذه السنوات من التحولات؟ يصمت الغيطاني: “الآن، الأمر مختلف، أشعر أنني باطني أكثر، بل أشعر أنني متفرد عن الواقع أكثر من كوني مشاركا فيه”. هل تغيرات قناعاته التي حُبس بسببها في الستينيات؟ ينفي الأمر: “ما زلت اشتراكيا رغم كل شيء، ولكن رؤيتي للاشتراكية اختلفت عن ذي قبل. الأفكار هي هي، ولكن أخذت منحنى آخر، كنا نظن أن الحل الوحيد هو الاشتراكية العلمية التي فشلت ولكن تبق العدل الاجتماعي، الإحساس بالانحياز للفقراء لم يتغير.. هل تشعر أن في كتاباتي أي ممالأة للأغنياء وللطبقات الجديدة؟”.

-2-
في السنوات الأخيرة، أصبح صاحب “التجليات” أكثر انشغالا بلغز الوجود، بفكرة الزمن والموت: “قد تندهش أن متعتي الأساسية الآن هي قراءة كتب الفيزياء والفلك، والكتب الفلسفية الكبرى، وكتب التصوف، قراءة الرواية تأتي في ذيل اهتماماتي.” وهذه الاهتمامات ربما يجد من خلالها إجابة لسؤال الزمن والوجود: “وكلها أيضا تصب في هم رئيسي هو الذاكرة.. عندما يزداد الوعي باقتراب النهاية يزداد الوعي بالذات ويتمحور حولها.. لذا، أشعر الآن أنني متفرج على ما يجري أمامي من أحداث”!
-
أسأله: صدر كتابك “رن” – الدفتر السادس من دفاتر التدوين بجملة فؤاد حداد الشعرية “وما الحياة إلا ذكري”، هل تصلح هذه العبارة مدخلا لقراءة لكل أعمالك؟ يجيب:
عندما قرأت هذه الجملة لفؤاد حداد، حدث لي حالة من الهلع، لأن عظمة الشعر أنه يلخص قانون الوجود في “بيت”. يعبر فؤاد حداد في هذه الجملة بالضبط عن رؤيتي للحياة، ليس فقط في “دفاتر التدوين”، ولكن في كل أعمالي. عندما تتابع أعمالي منذ البداية، ستجد أن “الزمن” عنصر أساسي فيها، كان موضوع التغيير والتحول من الموضوعات المحيرة لي جدا، والتي تثير تأملي.
في بداية العمر يخيل إليك أن ما تمر به باق أبدا، ولكن فجأة تبدأ عوامل الهدم والفناء والتحلل في العمل، تجد أن ما كان مستقرا لم يعد كذلك. وهنا يبدأ المرء في تأمل الأسباب، ومعرفة لماذا حدث ذلك. منذ البداية، شغلني الزمن، بدأت في مستوى خاص بالأسرة، ثم الحارة، ثم الكون. وهذا ما جعل لدى أسئلة كبرى منذ البداية. وربما كان هذا أحد الأسباب التي جعلتني مولعا بقراءة التاريخ، لا ليس قراءة وإنما “معايشة” للتاريخ.
مع العمر والتحولات التي تحدث في الحياة، تكتشف أن الحياة ما هي إلا “ذكرى” بالفعل. وبالمناسبة هذا المعنى ليس جديدا تماما، كثير من الشعراء تناول هذا الأمر، بل جوهر الشعر العربي هذه القضية: قضية الوجود، ثم المحو، والتبدل باستمرار. هذا موقف الشاعر العربي منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الحديث، فكل الشعر الكبير يقترب من هذه الحقيقة.
طبعا “دفاتر التدوين” ليست البداية المباشرة للتعامل مع الذاكرة، “الزيني بركات” تعتبر تعامل مع الذاكرة، لكن في إطار المطروق، بمعنى أنك تذهب إلى فترة سابقة لتضيء فترة حاضرة، من خلال شكل ومغامرة جديدة في التعبير. ولكن في “التجليات” عندما بدأت الظروف العامة التي مررت بها تتغير تغيرات جذرية بدأت محاولة الفهم والتفسير، وفي “دفاتر التدوين” بدأت محاولة إعادة بناء الذاكرة. بمعنى أنني أحاول أن أعيد بناء ما مضى مرة أخرى.
-
بهذا المعني، هل يمكن القول إن أعمالك تتناول ثلاثة محاور رئيسة: التاريخ، إعادة الفهم، ثم إعادة البناء؟
يمكن ذلك، ولكن مع تعديل بسيط. لكل كاتب هم أساسي في كل أعماله. الزمن هو همي الأساسي منذ مجموعتي الأولى “أوراق شاب” وحتى روايتي الجديدة “دفتر الإقامة “. حتى في الحدث الكبير هزيمة 67، الذي أعتقد أنه هيمن علي وعلى كل أبناء جيلي حتى هذه اللحظة. هذا الحدث دفعني للرحيل إلى العصر المملوكي، في محاولة لمعرفة أسباب ما جرى، واكتشف أنها أسباب واحدة. إنه رحيل في الزمن أيضا، أن تحاول تجاوز لحظة الهزيمة فتتخيل العودة إلى ألف سنة مضت.
الآن، مع مرور الزمن واقتراب الرحلة من نهايتها، يحدث تمركز على الذات أكثر، الذات باعتبارها مركز للعالم. هنا أذكر جملة جلال الدين الرومي: “لا تبحث عن المركز، أنت المركز”. وهذه زاوية صحيحة بالنسبة لي، لأنني بعد أن أرحل، لن يكون العالم بالنسبة لي موجودا، وأنا أيضا لن أكون موجودا. المهم هو تسجيل الرؤية والتجربة الإنسانية التي مررت بها، محاولة الفهم لي أولا، ثم بعد ذلك قد يوضح هذا أمرا غامضا للآخرين.
للأسف الشديد أن أعرف أننا سنمضي بدون أن نفهم أمورا كثيرة. قد تبدو آرائي ساذجة، ولكن هي حيرة الطفل الذي كان يسأل: “إمبارح راح فين؟” حتى هذه اللحظة.
-
في “الزيني بركات” كان اهتمامك بالزمن إلى الوراء… عودة إلى الماضي، ولكن في الأجزاء السبعة من “دفاتر التدوين” هناك اهتمام صوفي قد يؤدي إلى إلغاء لفكرة “الزمن” نفسها؟
لاحظ أنني كنت في حوار مع الزمن باستمرار. في “أوراق شاب” تخيلت أن هناك ألف عام مرت، وفي “الزيني بركات” عدت إلى الماضي أيضا. هذا هو الزمن السهل: السنة تعني اكتشاف دورة الفلك، ولكن بأي شيء ترتبط دورة الفلك؟ هل هي خاصة بكوكب الأرض؟ أم بالمجموعة الشمسية؟ أم بالكون؟ ومن صاحب الحركة الأولي؟ هذه هي القضية الكبرى في الفلسفة الإسلامية. بالطبع، الدين يحل لك المشكلة يجعلك تستكين، لكن من يبحث عن إجابات للأسئلة الصعبة لا يهدأ.
الكتابة هنا هي نوع من البحث، وبالتالي يستحيل تثبيت الزمن. لأنك تصل في النهاية إلى أنه لا يوجد طول أو عرض أو فوق أو تحت. لنفترض المستحيل، أننا استطعنا أن نعيش الألف عام القادمة أو المستقبل. فالمستقبل نفسه سيتحول أيضا إلى ماض. لا يوجد عندي حاضر، كل لحظة نمر بنا تصبح ماضيا، لا فرق بين لحظة انقضى على مرورها خمس دقائق، أو خمسة ملايين عام، كلاهما لا يمكن استعادتهما إلا بالذكرى، بالتذكر، باستدعاء المخيلة. ولهذا، أنا مقتنع جدا أنه لا يوجد “تاريخ”.
هل تعتقد أن تصوراتنا عن العصر المصري القديم مطابقة للوجود نفسه الذي كان قائما؟ أنت ترى هذه الفترة من زاوية مختلفة، تعيد لملمة الأشياء وتفهمها أيضا من زاوية مختلفة. لماذا لا أقول بالتالي إن المستقبل مثله مثل الماضي “مفقود”. “القادم” مفقود أيضا بالقدر نفسه المفقود فيه “ما مضى”. بالنسبة لي، ما الفرق بين لحظة عاش فيها الملك خوفو، وبين إنسان آخر سيأتي بعد 5 آلاف سنة؟ أنت لن ترى هذا ولا ذاك. إذن، نحن في حالة سفر دائم في لحظة لا تستطيع أن تمسك بها. وأنت مسافر، تفقد أشياء ولحظات وأحاسيس وأحباب، وفي النهاية تحاول عبر الكتابة أن تبق على شيء ما.
-
تختلف لغتك من عمل إلى آخر…. هل اختلاف اللغة له علاقة بالزمن؟
بالتأكيد. اللغة التي كتبت بها قصص”أوراق شاب..” أدت إلى “الزيني بركات”، وهي لغة القرن السادس عشر، وتحديدا لغة الحوليات في مصر. وأنا كانت مشكلتي الأساسية مع اللغة. أولا، كان لدي هاجس منذ البداية هو عدم الالتزام بالسائد. عندما قرأت نجيب محفوظ ويوسف إدريس، شعرت أنني أريد أن أكون مختلفا. كما أن قراءتي في الأدب المترجم كانت أكثر. هذا الاختلاف وجدته في النصوص القديمة. وقد ينصرف الذهن عندما نقول “التراث الأدبي” إلى المتنبي والجاحظ وأبي العلا، أنا ذهبت إلى نصوص غير مطروقة، إلى محاضر المحاكم الشرعية، وطبعا ابن إياس.
قرأت، وكنت أقرأ في ذلك الوقت الملاحم التي كانت معروضة في مكتبات وعلى سور الأزهر: عنترة بن شداد، سيف بن ذي يزن، الظاهر بيبرس، وطبعا ألف ليلة من البداية. في هذه الملاحم اكتشفت لغة غير موجودة في الروايات في ذلك الوقت. هذه اللغة، كيف يتم تطويعها لتصبح قادرة على التعبير عن شيء لا يمكن الإمساك به أو رؤيته أو التعبير عنه بالأحاسيس المجردة المباشرة. وجدت أنه لا يتم التعامل مع هذه اللغة رغم بلاغتها، وهذا جزء من مشكلة التحول من القديم إلى الجديد التي بدأت في القرن التاسع عشر.

-
هذا العصر الذي يسمي “عصر الانحطاط”؟
عصر الانحطاط، هذا هو عصر الكمال في اللغة. اللغة العربية عندما دخلت مصر كانت جامدة، وهذا ما تلاحظه في النصوص الأولى التي كان يكتبها العرب في مصر، مثل ابن الحكم في ” فتوح مصر والمغرب” كانت اللغة جامدة. بعد أربعة قرون، أصبحت اللغة العربية سائدة في مصر، حتى في العصر الفاطمي، كان الأقباط هم من يديرون الدواوين، وكانت القبطية هي المستخدمة في الدواوين. في العصر المملوكي، استقر الأمر، ولكن حدث عناق وامتزاج بين اللغة المصرية الدارجة، التي كانت محملة بتاريخ قديم جدا منذ أيام الفراعنة، ثم المرحلة القبطية واليونانية، وبين اللغة الوافدة العربية. ومن هنا، نشأت لغة وسيطة، في رأيي، هي ذروة البلاغة المصرية.
-
المصرية.. وليست “العربية”؟
هناك لغة عربية واحدة، ولكن بداخلها تنوع لا تشعر به إلا بالمعايشة. إيقاعات اللغة في الأندلس تختلف عن إيقاعات اللغة في العراق مثلا، وهكذا. في مصر، اللغة العربية لم تدخل على فراغ، فيما يسميه البعض عصر الانحطاط، حدث تصالح بين اللغة العربية الوافدة وبين اللغة المصرية وإيقاعاتها العامية. ولذا، لم أكتب بالعامية، حتى في الحوار، لأن في اللغة العربية إمكانيات الإيهام، يمكنك أن تقرأ إيقاعا فصيحا بلهجة عامية.
هذه التجربة التي تمت في العصر المملوكي حاولت أن أتواصل معها. في “الزيني بركات” حاولت أن أتناص مع هذا العصر، ولكن عندما كتبت “وقائع حارة الزعفراني” حاولت أن أغير، لأنني أؤمن أن اللغة “حالة” تتبدل وتتغير وليست “مقاما”. ولهذا، من أكثر الأشياء التي تثير سخريتي، عندما يقول أحد إن هذا الأديب “أسلوبه كويس”!. كأنك تأتى بحلة “مرق” وتضعها على أصناف متعددة من الطعام فينتج عنها مذاق واحد.
الأفضل أن يكون لكل صنف “مرقه” الخاص، حتى تجد مذاقات مختلفة. ولذلك، اللغة التي استخدمتها في الزيني بركات انتهى مبرر استخدامها بانتهاء الرواية.
في “التجليات”، تماهيت مع النصوص الصوفية الكبرى، ولكن بداية من “شطح المدينة” شعرت أنني خرجت من حالات التماهي والتواصل مع المصادر القديمة إلى حالة لغوية خاصة، حالة تستوعب أساليب القص كافة.
-
عندما نشرت “أوراق شاب..” كانت أحد همومك كيف تختلف عن السائد. ذهبت إلى النصوص القديمة… لماذا لم تكن هزيمة 67 قد حدثت بعد ولم تبدأ “أزمة الهوية”، كما أن أكثر قراءاتك كانت في الأدب المترجم. كيف حدث هذا الوعي بالرغبة في الاختلاف؟
المكان… كوني أنا المكان وليس الكتب. لم يكن في بيتنا مكتبة، وعندما بدأت الكتابة، كان أحد مصادر بحثي عن الكتب دكاكين الورق المستعمل. ومن دكاكين الورق اقتنيت “ذخائر” كانت تباع بالكيلو، اقتنيت مجلدات “الوقائع المصرية” التي كان يرأس تحريرها الإمام محمد عبده، وجريدة “المؤيد” للشيخ على يوسف.
كما أن الأزهر القريب من بيتي ساعدني على التكوين، لوجود المكتبات المحيطة به. ظللت لسنوات طويلة أتعامل مع الكتب المستعملة، لدرجة أن شراء كتاب جديد كانت فكرة نادرة بالنسبة لي. كان أول كتاب اشتريته “فن القصة القصيرة” لرشاد رشدي سنة 1961، وبعد أن قرأته اكتشفت أنني كان لابد أن لا أقرأه، لأنه “يؤطر” المبدع، يقول لك: هكذا تكتب القصة.
-
هل هذا جعلك تنفر من فكرة قراءة الكتب النقدية؟
لا على الإطلاق، بالعكس قرأت مئات الكتب النقدية. نشرت أول قصة قصيرة لي عام 1963، وبعدها بشهر واحد نشرت عرضا لكتاب “القصة السيكولوجية” لـ”يون إيدل”، الذي لعب دورا كبيرا في تكويني، وكان يتوقف عند تجارب تيار الوعي، مارسيل بروست، مارتان دوجار، هنري جيمس وجيمس جويس.
قرأت عن أعمال قبل أن أقرأها، وأبرز مثال في ذلك كانت عوليس، التي تأثرنا بها قبل أن نقرأها. ولكن في الوقت ذاته، كانت قراءتي الأساسية في الفلسفة، والكون، والتاريخ.
-
في “الزيني بركات” تعود إلى التاريخ.. ثمة روايات أخرى كثيرة سبقتك في ذلك، مثل جورجي زيدان، وآخرين… ما الفرق؟
أنا قرأت مصادر التاريخ المملوكي قبل67 ، وكنت منبهرا به، سواء اللغة، أو التلقائية في التعبير، أو طرق السرد وغيرها. كما أن أحد الأشياء المثيرة بالنسبة لي أن الأحداث التي أقرأها تدور في المكان الذي أعيش فيه.. يعني أقرأ “وشق موكب السلطان قصر الشوق”، وأنا أسكن في قصر الشوق.
عندما حدثت 67 كنت خارجا من المعتقل، وكنت وقتها قد كتبت قصصا قصيرة عن السجن، مثل رسالة فتاة من الشمال، أو المغول وغيرها، وكتبت ثلاث روايات عن القمع، فقدتهم عندما تم اعتقالي. أي أن موضوع القهر بالنسبة لي كان موضوعا أساسيا. ولكن عندما حدثت الهزيمة، أصبح الوطن في خطر ليس فقط أنا، لم أجلس في مكاني، وإنما قررت أن أتطوع في الجبهة، وذهبت بالفعل. وعندما عملت في الصحافة، اخترت أن أكون مراسلا عسكريا. الوطن أصبح له الأولوية.
لذلك، في “الزيني بركات” عدت إلى فترة حدثت فيها هزيمة مثل هذه الهزيمة التي تعرض لها جيلنا. لم أذهب إلى فترة فيها انتصار على أساس أنك “تعزي”. لاحظ أيضا أن إمكانية تجاوز الهزيمة كانت تلوح، لأن مصر انهزمت في العصر المملوكي وتحولت إلى ولاية بعد أن كانت سلطنة، ثم جاء الاحتلال العثماني البشع، ولكن بعد ذلك جاء محمد علي الذي حول مصر إلى دولة عظمى.
كنت أريد أن أقول إن تاريخ مصر هكذا: صعود وهبوط. في تلك الفترة من تاريخ مصر المملوكية، حدثت الهزيمة لنفس الأسباب التي جعلتنا نُهزم أيضا في 67. كأن التاريخ يعيد نفسه. وللأسف، العصر المملوكي في مصر لم ينته، لأن القيمة الجوهرية فيه كانت “الشخص”، وليست “الإمكانية” لدرجة أنني أريد أن أكتب قاموسا للحكم في مصر، أجمع فيه العبارات الحاكمة التي تلخص قانون الحكم.
-
هل كنت تتنبأ بالهزيمة؟
كنت أشعر أن هناك خلل ما، في قصصي الأولى ستجد نقدا حادا للوضع. لكن للأسف، الوضع الذي كنا ننتقده في الستينيات لا يقاس بما حدث في السبعينيات. ويبدو الآن كـ”جنة”. يستكمل الغيطاني: كل الروايات الكبيرة عندي تبدأ بأنغام تمهيدية اسمها القصة القصيرة.
ستجد إرهاصاتها في قصص “المقشرة”،”إتحاف الزمان بحكاية جلبي السلطان”، وفيها همي الأساسي: قضية الحرية، وقضية المجتمع الذي ينهار. وأعتقد أن الكلمة التي كتبت على غلاف الطبعة السورية للزيني بركات أدركت قانون الرواية بالضبط: “إنها رواية تستعيد التاريخ، ولا تعيده”. وهذا هو الفرق بيني وبين جورجي زيدان، وسعد مكاوي، ومحمد سعيد العريان، الذي كتب عن نفس المرحلة روايته “على باب زويلة”.

-4-
لم يكتب الغيطاني عن حرب أكتوبر حتى الآن. كتب عن تداعيات الحرب على المجتمع المصري، وربما ستكون موضوعا لأحد “دفاتر التدوين”. لكنه اهتم أكثر بالتأثيرات السياسية للحرب وما تلاها من سلام ناقص، كما أن استخدام السادات للحرب كمبرر لكل الفسق الاجتماعي الذي حدث في المجتمع، بدلا من أن يكتب روايته الكبرى عما شاهد في حرب أكتوبر إلى ما يسميه “زمن المرثية”، وهو ما عبر عنه بشدة في روايته “التجليات”.
بعد التجليات، أصبح يقول: “أجسر على المغامرة.. كل كتاب مغامرة لا يعرف إلى أن يقوده”. ربما هذا ما يفسر الخصوصية في كتاباته الأخيرة (دفاتر التدوين)، التي بلغت سبعة دفاتر حتى الآن، وهي أبعد ما تكون عن السيرة الذاتية، لكنها محاولة “إيهام القارئ بأنها سيرة ذاتية، أو ما يسميه الناقد المغربي محمد برادة بـ”التخييل الذاتي”.
يضحك الغيطاني: “أنا لم أتزوج بغدادية مثلا.. لكنني أكتب عن أشياء تمنيت أن أفعلها”. يوضح صاحب “الزويل”: “مع التقدم في الرحلة، تذوب الفوارق بين الشخصيات العيانية التي تعرفها، والشخصيات التي لم تعرفها. لذا أعيش مع شخصيات الخيال أكثر من الموجودين فعليا”.
لا ينسى الغيطاني أسماء الكبار: إيفو أندريتش، ولا دينو بوتزاتي، هيرمان ملفيل، ولا شخصيات دوستويفسكي الشهيرة، كما لا ينسى أبا العلا المعري، ويقول: “منذ عامين وأنا افتتح “قعدة القراءة” بأشعاره، هو الشاعر المصاحب لي، وأثناء قراءتي للنص، أكون قد كونت صورة له… شكله، طريقة كلامه”.
يمتلك صاحب “متون الأهرام” مكتبة موسيقى هائلة، تضم موسيقى العالم تقريبا، أقربها له الموسيقى الإيرانية، والتركية. وقد أصابنا نحن العاملون معه، بعضا من فيضه. فقد أعتقد ذات يوم أن هذه المكتبة يمكن أن تفسد، فقرر أن ينسخ منها نسخة أخرى “احتياطية”. وعندما ظهرت أجهزة أحدث، أصبح لديه من كل نسخة عدد من النسخ مرات على الـCD، وأخرى على فلاش ميميوري، وثالثة على آي بود.
مقاومة للنسيان.. هل هذا ما تريد أن تؤكد عليه عبر الكتابة؟ يضحك: “الكتابة ليست مقاومة للنسيان.. إنها مقاومة للموت”.
الذاكرة، من وجهة نظر الغيطاني، هي الوجود الحقيقي للإنسان. كثيرا من شاهد أناسا أصيبوا بالزهايمر، كانوا مثل خرقة بالية، يصبح الإنسان معلقا في الفراغ، وهذا هو الرعب ولكن كما يقول: “علينا أن ننتبه إلى أن شرط الذاكرة هو النسيان لأنه من المستحيل أن يتذكر الإنسان كل ما مر به. لا بد أن تسقط أشياء حتى يمكن التذكر”.
لا يعرف الغيطاني قوانين عمل الذاكرة، لكن يلحظ أن التذكر يتعامل مع الصامت دائما، وليس الناطق. تستعيد الأشياء في صورتها الثابتة.
يوضح فكرته: “عندما كان أخي في أمريكا للدراسة، طلبت من أمي أن تسجل صوتها في رسالة لرسلها له، ولكنها رحلت، احتفظت بشريط كاسيت عليه صوتها. أضعه الآن في درج مكتبي، ولا أجرؤ حتى الآن أن استمع إليه… أحتفظ بالشريط لأن به شيئا منها، ولكن لا أستمع إلى صوتها”. فقدان الذاكرة يراه الغيطاني هو الموت الفعلي، هو موت الداخل، أما موت الخارج فأسهل كثيرا، واقترب منه أكثر من مرة… وخاصة أثناء عمله كمراسل حربي.. يضحك: “أنا أعيش بالصدفة”.
أثناء حرب الاستنزاف، كان يجلس على أحد المقاهي في مدينة السويس، وترك مقعده إلى المقعد المجاور، ليجلس عليه رجل إطفاء، وفجأة حدثت غارة جوية، وسقط رجل المطافي.أخذنا نقلب فيه لا يوجد أي شيء، وفجأة وجدنا “سرسوب” دم من وراء الأذن نتيجة شظية طائرة دخلت.
يقول الغيطاني: “تخيل لو كنت غيرت المكان”، والمدهش أيضا أن الغيطاني اتفق مع المصور مكرم جاد الكريم وكان زميله المصاحب له على الجبهة بأن يطلقا النار على أنفسهم إذا تعرضوا للأسر وكنا نرتب لهذا الانتحار..”كنا نعرف الكثير من الأسرار العسكرية، قد نتحمل التعذيب، ولكن ماذا لو أعطونا أي مشروبات مثلا تجعلنا نتكلم عن هذه الأسرار”.
سافر الغيطاني والشاعر الراحل محمود درويش سويا إلى باريس للمشاركة في لقاء أدبي. تبادلا خبرات خاصة في أمراض القلب، الذي يجمعهما سويا. في تلك الرحلة
- قال الغيطاني لدرويش: “إنني أمرض عندما لا أكتب”.
- فسأله درويش: “وماذا عن القراءة؟”.
- قال الغيطاني: “لا أتوقف عن القراءة أبدا”.
- فقال درويش: “اطمئن إذن على نفسك”.
الكتابة هي الحياة، هي تشبه “الرغبة الجنسية”. ولهذا هو يطمئن على نفسه، ولكن الشيء الذي يخشاه “متاعب النهايات”. يقول: “لا أنسى نجيب محفوظ في أيامه الأخيرة، عندما كانت لديه الرغبة في الكتابة، لكن يده لا تطاوعه. كان يريد أن يسمع أغنية ما، ولكن لا يستطيع.. هذا هو الموت البطيء، وهذا أكثر ما يخيفني”.
اقرأ أيضا:
هاني فوزي يكتب: «دفاتر تدوين الغيطاني».. إبداع على غير مثال سابق